كلّ ما تريد معرفته حول اللغة الأمازيغية ومشكلاتها في الجزائر - “تمازيغت” هل هي لغة أم مجرد لهجات؟ أهم اللهجات المحلية للأمازيغية بالجزائر .. الأكاديمية البربرية (أكراو إيمازيغن).. إلى ماذا تهدف؟
الفرد يتأثر باللغة التي يتكلمها، بحيث يمتد هذا التأثير ليشمل نمط تفكيره وتصوراته ومشاعره ، يقول شيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعدالله، ويضيف الدكتور سفيان لوصيف “إن اللغة ليست مجرد أداة تلقي المعرفة والتفكير، إنها الفكر نفسه، فليس ثمة فكر مجرد بغير رموز لغوية.
ولأهمية اللغة ونقاش الهوية لدى إنسان شمال أفريقيا بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص، أثار ترسيم ((تمازيغت)) بالدستور الجديد للجزائر نقاشا قديمًا بين النّخب عبر مختلف وسائل الإعلام، وتجدد فتح الملف مرة أخرى حيث حولته مواقع التواصل الاجتماعي إلى مادة دسمة لصراع الهوية.
فتيار عريض من المنادين بتمكين اللغة الأمازيغية يعتقدون أن حكومات هذه الدول عملت كل ما في وسعها منذ الاستقلال .. لإقصاء التيار الأمازيغي وطمس هويته وتغليب العربية في كل المجالات، في حين يرى البعض الآخر أن حزب فرنسا يحاول استدراج المجتمع إلى الصراع العربي الأمازيغي لتمكين اللغة الفرنسية على غرار ما هو موجود في العديد من المستعمرات الأفريقية.
وبهذا التقرير سنحاول دراسة مسألة تطور الأمازيغية في الجزائر، هل فعلا ((تمازيغت)) عبارة عن لغة؟ وإذا كانت لغة متكاملة هل لها القدرة على فرض نفسها إداريًّا وإعلاميًّا وعلميًّا؟ كما سنتطرق إلى سياسة التعريب وأزمة اللغة في البلاد والصراع بين حزب الجزائر وفرنسا بخصوص الهوية، وما تأثير تمازيغيت على الشخصية الجزائرية..؟
هذه هي أهم اللهجات المحلية للأمازيغية بالجزائر
وتتواجد بالجزائر عدة لهجات وتنوعات أمازيغية، تدعى بالقبايلية أو الشاوية أو المزابية وغير ذلك حسب المناطق، وتتوزع كالتالي: اللهجة الشاوية بالشرق الجزائري، اللهجة القبائلية والشناوية بالوسط الجزائري، اللهجة الزناتية بالجنوب الغربي للجزائر، واللهجة الميزابية والطارقية بالجنوب الجزائري.
ومع ذلك تعتبر اللهجة القبائلية أكبر اللهجات انتشارًا في الجزائر، ويشير بعض المختصين إلى تحدث أكثر من أربعة ملايين جزائري بالداخل بهذه اللهجة، بالإضافة إلى بعض سكان الجزائر بالمهجر في فرنسا وأوروبا بشكل عام والذين لديهم أصول أمازيغية، وبهذا الخصوص نشرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن لاعب كرة القدم الشهير زين الدين زيدان تحدث أبويه باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة الفرنسية في البيت في ضواحي مارسيليا (جنوب فرنسا).
وبعد الفتح الإسلامي للمنطقة، اتضح التنسيق والتكامل اللغوي بين العربية والأمازيغية لدى الكثيرين من السكان، وهذا بعد تبنيهم للدين الإسلامي كعقيدة دافع عنها الكثير من القادة الذين خلدوا في التاريخ الإسلامي ولعل أبرزهم طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين.
التناغم اللغوي الذي حدث بين العربية والأمازيغية، نفسه حدث مع لغات أخرى مثل الإسبانية والتركية والبرتغالية والفرنسية لكن بدرجة أقل، وهو ما يترجم استعمال الجزائريين لكلمات أجنبية في استعمالهم اليومي للدارجة (العامية)، إلا أن اللغة الفرنسية التي هي لغة المستعمر ترهن الأمازيغية عبر حرفها عند المؤيدين وأصحاب النزعة البربرية المتطرفة كما سنشير لاحقا.
- تمازيغت هل هي لغة أم مجرد لهجات.؟
تشير الأكاديمية ليلى خلف السبعان؛ رئيسة تحرير مجلة العربي، إلى أن اللغة ليست عبارة عن إرث ثقافي يعكس الماضي، أو عبارة عن وسيلة تدوين وتواصل فقط، بل هي جوهر التقدم في مجتمع المعلومات إذا توفرت شروط التمكين لها ولأجيالها بالتداول، ومنه نطرح تساؤلًا كبيرًا: هل بإمكان تمازيغت أن تكون لغة مجتمع معلومات؟ وكم تحتاج من وقت لأن تتحول إلى لغة قادرة على مواكبة تطورات العصر؟ في حين يتجه العالم اليوم إلى طمس وإلغاء العديد من اللغات واللهجات المحلية. وقبل ذلك: هل هي لغة أم مجموعة لهجات محلية؟
فالحديث عن ماهية اللغة، هو حديث عن مدخلات اجتماعية وزمانية لتطور اللغة، يقول الباحث المغربي في قضايا الهوية الأمازيغية محمد كوخي، إن أحد أبرز الأمثلة لعبثية قرار نخبة ثقافية بصناعة لغة جديدة خارج السياق الاجتماعي والتاريخي لنشوء وتطور اللغات وحاضنتها الطبيعية، هو نموذج اللغات الاصطناعية التي ُتَعد أنجحها عموما «لغة الإسبرانتو» (Esperanto) التي طّورها في أواخر القرن التاسع عشر مجموعة من المثقفين والأدباء في أوروبا من لغات مختلفة، منها الفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنكليزية والألمانية وغيرها، كمشروع لغة عالمية جديدة يمكنها أن تصير لغة التواصل بين جميع البشر. وقد قام هؤلاء بنشر أعمال أدبية كثيرة بهذه اللغة، وخّلفوا تراثًا أدبًيا وفكرًيا متمّيًزا على مدى حوالي قرن ونصف قرن من الزمن. لكن هذه اللغة التي طمح أصحابها إلى أن تكون اللغة العالمية الموحدة، انتهى بها المطاف إلى التقوقع وانحسار تداولها في بضع مئات من الأفراد في وقتنا الراهن.
ولنعُدْ إلى أصل “تمازيغت” التي يعتبرها المؤرخون وعلماء اللغة إحدى اللغات الأفريقية الحيّة، حيث تمتد من ليبيا وبعض قبائل التشاد شرقًا إلى جزر الكناري بالمحيط الأطلنطي غربًا (عمل الإسبان على إلغائها تماما لدى قبائل الغوانش، وبدأت بالعودة تدريجيًا)، ومن أشهر الملوك الذين تحدثوا بالأمازيغية هم يوغرطة، شوشناق، ماسينيسا ويوسف بن تاشفين.
كما تعتبر “تمازيغت” لغة شمال أفريقيا لغة حامية مثل المصرية القديمة، ويقول الباحث المغربي في اللغات محمد المدلولي أنه يمكن اعتبار اللغة الأمازيغية متفرعة مباشرة من اللغات السامية، غير أن بعض الباحثين كأحمد بوكوس يرون أن الأمازيغية ليست حامية ولا سامية وإنما لغة مستقلة بذاتها. ويرى كارل برسه أن الأمازيغية لغة متأثرة باللغات الأفريقية الآسيوية أي الحامو-سامية وأن الكلمات المشتركة بين اللغات الأفريقية الآسيوية هي ثلاثمائة كلمة.
ومنه يمكن القول أن “تمازيغيت” هي لغة تفككت إلى لهجات عديدة حسب القبائل المنتشرة جغرافيا بأقاليم شمال أفريقيا الممتدة على مسافات ومساحات واسعة، وهذه اللهجات لم يعمل سكان أفريقيا على تطويرها كتابيًا لذلك ما زال المتخصصون في اللغة الأمازيغية بالجامعات في حيرة من أمرهم بخصوص ربط اللهجات المحلية باللغة الأكاديمية، ومبرر ذلك أنه يوجد فرق شاسع بين هذين الاتجاهين حيث الأولى يتحادث بها السكان شفهيًا في حين الثانية تخضع لقواعد معينة في كتابتها ونطقها.
كما أنها – أي تمازيغت – لا تحتكم إلى حرف موحّد لتطويرها وهو بالضرورة حرف “التيفيناغ”، لأن أي لغة بالعالم ترغب في حجز مكانها تتقوى من خلال حرفها الخاص، ولذلك تعاني اللغة الأمازيغية من عدم الاستقرار على مستوى الكتابة في حين يبقى تداولها على الألسن غير كاف لاستمرارها كلغة في المستقبل لدى الأجيال، وهو ما يترجم الصراع الخفي بين دعاة الحرف الفرنسي والعربي للّغة، وهو صراع أيديولوجي أكثر منه تمكينًا لتمازيغت وإعادة الاعتبار لها كلغة تحتاج إلى الرعاية والتطوير.
تمازيغت تعاني الأمّرين هل هي صراع على الحرف او متاجرة السّاسة في الجزائر..
وإذا ما أشرنا إلى الممارسة السياسية لمؤسسات الدولة تجاه اللغة الأمازيغية في الجزائر، نجد أنها كإرث ثقافي تتوجه نحو الانقراض والتفكك، في وقت يتوقع خبراء اليونسكو انقراض أكثر من 3 آلاف لغة تمثل نصف لغات العالم بنهاية القرن الحادي والعشرين، أي أن هناك لغة واحدة على الأغلب تنقرض كل أسبوعين، ويعتبر العديد من الكتاب أن الهوية الأمازيغية برمتها تضررت من السياسة والصراع الدائر بها في الجزائر، على خلاف الجارة المغرب التي تجاوزت هذا النقاش مؤقتا من خلال إجراءات في صالح الثقافة الأمازيغية (لغة وتراثًا) بمختلف مؤسسات المملكة.
فاللغة الأمازيغية تعيش غموضًا كبيرا بخصوص ترقيتها والاعتناء بها وتطويرها، فمع الخلاف الحاصل حول الحرف الذي تكتب به بين التيفيناغ، أم بالحرف العربي كما يستعمل ذلك المحافظون من مجتمع الأمازيغ في وسط الجزائر، أم ستخضع للأمر الواقع ويتم خطها بالحرف اللاتيني مثل ما يفرضه بعض المثقفين من قبائل الشمال الجزائري، والحركات السياسية التي تتذرع بالإقصاء! تعمل أكاديمية بربرية بالعاصمة الفرنسية باريس على تكوين وإعداد النشطاء الأمازيغ للمطالبة بالاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل عن الجزائر، وتمدهم حسب هؤلاء النشطاء بحقيقة الاحتلال العربي الإسلامي للجزائر في القرون الماضية، أي منذ اعتناق البربر للإسلام في القرن السابع الميلادي (الأول الهجري).
ركزّت الحركة الوطنية ومختلف هيئات الإصلاح والسياسة وقت الاستعمار الفرنسي على وحدة الهوية الإسلامية، وتتمثل أسس الهوية الجزائرية في الإسلام دينًا والعربية لغةً، وعملت جمعية العلماء المسلمين على هذين البعدين، في حين فصل بيان أول نوفمبر الذي يعتبر مرجعية الجزائريين بمختلف طوائفهم وألوانهم السياسية والأيديولوجية على اعتبار الجزائر دولة مسلمة، حيث بيّنت الهدف الأول من الثورة وهو “إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السّيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية”، وأضاف البيان هدفًا خارجيًا مفاده .. تحقيق وحدة شمال أفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي.
ويبقى السؤال المطروح: كيف تصرفت فرنسا مع الهوية الأمازيغية، وهل شجعت أم انتقمت من “تمازيغت” مثلما فعلت بالعربية إبان استعمارها للجزائر طيلة مائة واثنتين وثلاثين سنة؟ تابع معنا بقيَّة التقرير لتتضح لك الصورة جيدًا..
الاستعمار الفرنسي والتمكين للقومية البربرية عن طريق “تمازيغت”..
لقد عملت فرنسا من خلال وسائل وأدوات كثيرة على خلق صراع بين العربية والأمازيغية، وأدركت فرنسا جيدًا الخصوصية اللغوية للمجتمع الجزائري مثلما يقول محمد الميلي (مجاهد وكاتب جزائري مقيم في باريس ولد سنة 1929)، حيث اجتهدت على خلق نزعة بربرية معادية لعروبة الجزائر، يضيف الميلي أن الفرنسيين انطلقوا من فكرة مسلّمة عندهم وهي أن تعريب البربر جزئي غير مكتمل، وهم أكثر قابلية للتكيف مع اللغة الفرنسية وثقافتها، أو كما قال أحدهم “البربر كانوا بالأمس نصف متوحشين وسوف يتكلمون الفرنسية في بضع سنين”.
يقول أوغست وارنرAuguste Warnie"r" سياسي وكاتب فرنسي (1810-1875) “لو أنه بدل أن يطلب من المعمرين احترام القومية العربية، وهو احترام يتنافى مع الحضارة، طالب بالحقوق المشروعة للقومية البربرية”، في نداء منه للمثقفين والمعمرين الفرنسيين بالجزائر، وهي فكرة جاءت من أجل تشجيع وتثمين إدماج المجتمع الجزائري بالسياسة الثقافية الفرنسية.
وأطلقت فرنسا في 7 آذار/مارس 1944 مشروع قانون أصدرته اللجنة الفرنسية للتحرير برئاسة شارل ديغول لمنح شهادات تعليمية باللهجة البربرية للجزائريين، واعتبروا تقوية اللهجة البربرية هو بديلًا واقعيًّا لهيمنة اللغة العربية الفصحى (بعد جهد جمعية العلماء المسلمين في ذلك الوقت)، وعمل المشروع الذي أعد له جيدًا بنية طرد اللغة العربية من كامل التراب الوطني للبلاد بعد نجاحه بمنطقة القبائل التي ركزت عليها فرنسا كثيرًا.
ومع الاستقلال، أثار الكثير من الكتاب والأدباء أمثال محمد ديب ومولود معمري وآسيا جبار وكاتب ياسين، نقاش اللغة والهوية بجدية، اتفق هؤلاء بالإضافة إلى مالك حداد والبشير الإبراهيمي في كتاباتهم على وجود أربع لغات بالجزائر، هي الفصحى العربية، الفرنسية، العاميتان الدارجة والأمازيغية.
وينسب الدكتور أحمد بن نعمان في كتابه “فرنسا والأطروحة البربرية” تصريحًا للباحث الجزائري عثمان سعدي (صاحب كتاب عروبة الجزائري عبر التاريخ) “لقد تعلم أنصار النزعة البربرية على أيدي فرنسيين، وعلى أيدي الآباء البيض، فغرسوا في نفوسهم كرههم لكل ما هو عربي وعلموهم بالفرنسية (أن العرب غزاة وأن العربية لغة غازية وأن البربر جرمان هاجروا من أوروبا) ليبرروا (فرنسة الجزائر) قبل 1962″. ويضيف أن الوالي الفرنسي للجزائر شاتينون قام سنة 1948 بتدمير حزب الشعب الجزائري من خلال بث النزعة البربرية في صفوفه لما اكتشف أنه يشكل خطرًا على التواجد الفرنسي على أرض الجزائر”.
وللعلم يعتبر كل من عثمان سعدي وأحمد بن نعمان إحدى الشخصيات ذات الأصل الأمازيغي في البلاد، ويعتبر هذا الأخير أشد المعارضين لترسيم اللغة الأمازيغية وتعميمها في الجزائر، حيث نشر مؤخرا بيانات عديدة، ويناضل مع الكثيرين لأجل توقيف القرار الدستوري بدسترة الأمازيغية حيث يعتبرها خطرًا على وحدة الجزائر، ومشروعًا مستقبليًّا لتقسيم البلاد إلى إثنيات متطاحنة.
الأكاديمية البربرية (أكراو إيمازيغن).. إلى ماذا تهدف؟
انبثقت النزعة الأمازيغية النشطة من الأكاديمية الأمازيغية أو البربرية L’Académie berbère “أكراو إيمازيغن” في باريس والتي تأسست سنة 1967، وهي ذات اتجاه راديكالي، تشتغل على صقل المنتسبين إليها بشخصيات ذات توجه سياسي “متطرف” في كل ما يتعلق بالقومية البربرية والهوية الأمازيغية، لمواجهة “الهيمنة العربية الإسلامية” التي يمكِّن لها النظام السياسي في الجزائر حسب اعتقادهم.
وتمكن هذا التيار من المهاجرين من سكان الأمازيغ “خاصة القبائل” بضواحي باريس وفرنسا عمومًا، حيث ضمّت الأكاديمية في أوج تأثيرها أكثر من 1000 منتسب (مناضل)، وعملت على نشر مجلاتها ودورياتها الثقافية والعلمية، بالأوساط الجزائرية والمغربية والليبية المتنقلة إلى فرنسا.
كما عملت على تشجيع شباب وطلبة جامعات الولايات المحسوبة على منطقة القبائل على النشاط النقابي والثقافي والرياضي داخل الجامعة، فحتى الآن لا يوجد أي فريق كرة قدم تخضع تسميته للجهوية أو العرقية سوى فريقي شبيبة القبائل (الوسط الجزائري) واتحاد الشاوية (الشرق الجزائري)، في حين ينص القانون على أن اعتماد الجمعيات الرياضية والسياسية والثقافية لا يجب أن يكون على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جنسي!
ويدافع المؤرخ الجزائري أرزقي فراد عن الأكاديمية البربرية التي حُلَّت عام 1978، لم تكن ذات نزعة بربرية متطرفة حسبه في حوار مع يومية الشروق، ويضرب مثالا عن المصلحين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده اللذيْن اضطرا إلى الفرار بفكرهما الإصلاحي تجاه العاصمة الفرنسية باريس. يتساءل أرزقي فراد: “هل يمكن أن نصِفَ هذين المصلحين بخيانة الوطن؟”، مضيفًا: “لقد التجأ أنصار القضية الأمازيغية إلى فرنسا لأنها تتوفر على جو ديمقراطي يجعلك تهتم بقضيتك الثقافية، وهناك جالية جزائرية كبيرة كانت رافدًا قويًّا للثقافة الأمازيغية بصفة عامة، خاصة في المجال الغنائي”.
واشتغل بعض الفاعلين من الأكاديمية على تقديم دروس وإصدارات بجامعة الجزائر، مثل مولود معمري وطاووس عمروش، وتكثف النضال من أجل الأمازيغية مع الأغنية القبائلية الجديدة، خاصة مع صعود نجوم فنيين مؤدلجين مثل المغني إيدير حميد شريت (ولد عام 1949) ومعطوب الوناس (1956-1998) ولونيس إيت منقلات (ولد عام 1950) وغيرهم، وبالتالي تحولت الأمازيغية من قضية لغوية إلى أيديولوجية تبنتها النخب الثقافية والفنية والرياضية بشكل واسع مع مرور الوقت.
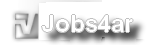


 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


