مراجعة للفلسفة - الثقافة والحضارة
منتدى الفلسفة والعلوم الانسانية منتدى الباكالوريا - منتدى الآداب و العلوم الإنسانيّـة - فلسفيات الباكالوريا آداب وشعب علمية بكالوريا علوم - باكالوريا آداب بكالوريا الجزائر بكالوريا المغرب - منتدى الفلسفة منتدى علم الاجتماع منتدى علم النفس
في استشكال الصلة بين مفهومي "الثقافة" و«الحضارة:
مدخل مفاهيمي إلى النقاشات الدائرة اليوم حول المفهومين
محمد الشيخ
للفظ «الثقافة» -كما للفظ «الحضارة»- تقاليد في الاستعمال داخل الفكر الغربي -فرنسية وإنجليزية وألمانية- وغيره. وهي تقاليد تآلفت تارة وتخالفت أخرى، وتلاقحت طورا وتنافرت طورا آخر. هذا إذا ما نحن اعتبرنا اللفظين كل على حدة، أما إذا ما نحن نظرنا إلى أوجه تعالقها -وهي كثيرة مشكلة ولها تاريخ مديد- فإن الأمر يصير أعقد، لا سيما عند الألمان حيث التخالف بين المفهومين ذهب مذهبا قصيا حد التعارض.
ينظر هذا المقال في مسيرة اللفظتين، فردا فردا، ثم في أوجه تعالقهما، مثنى، ويستقصي عن أهم النقاشات التي أثارها هذا التعالق منذ أن كان، ويعرض إلى النقاشات الدائرة اليوم عن المفهومين.
- 1 -
في أصول مفهوم «الثقافة»:
تعود مختلف تقاليب لفظ «الثقافة» في الألسن الغربية الأساسية الحديثة -من لسان فرنسي Culture وجرمانيKultur وإنجليزي Culture وغيرها...- إلى اللفظ اللاتيني Cultura الذي يعني، في معناه البدئي، «فلاحة الأرض» و«تبديل وجه الطبيعة». وهو يتضمن، من بين ما يتضمنه من دلالات، دلالتين اقترنتا في اللسان اللاتيني وافترقتا في غيره من الألسن؛ نعني ما دل عليه لفظ Colere من دلالة «السكن» و«التعبد» في آن. على أنه ما استقرت دلالته الحصرية التي صارت له فيما بعد، في لسان أهل رومية، إلاَّ مع الحكيم ورجل السياسة والخطيب الروماني شيشرون (106-43 ق.م)؛ بحيث أقر اللفظ على دلالة «تثقيف الذهن» و«تشكيل الفرد وتهذيب ذوقه» بما وشى، أول ما وشى، بتقابل بين أمرين: الشأن «الطبيعي» والشأن «الصنعي»، من جهة أولى، والأمر «الكوني» والأمر «الخصوصي»، من جهة ثانية؛ أي ما في الإنسان بالطبع وما فيه بالتطبع: الأول فطري طبيعي كوني. والثاني صنعي قومي كسبي - وهو المعنى الذي ضمه لفظ «الثقافة»(1).
والحال أنه لا وجود في اللسان اليوناني الذي أورث الفكر الغربي اصطلاحاته الأساس للفظ «الثقافة»، وإنما يوجد فيه ما يقابل دال «التثقيف» عندنا، وقد وسموه بالوسم Paiedeia. قال الحكيم اليوناني الذري ديمقريطس: «التثقيفPaiedeia إكليل على رأس أولئك الذين تسير الأمور عندهم السير أحسنه، وهو بالمقابل ملاذ أولئك الذين يسير أمورهم السير أسوأه»؛ بما أفاد أن معنى أن يتثقف المرء إنما هو أن يزداد حسن سيرته حسنا، والتثقيف هذا أمر لا يضر الشقي بل يجد فيه السلوى والعزاء. هذا ولقد تعلق فعل «التثقيف»، عند اليونان، بالنشء أولا وبدءا، من حيث هو عمر من أعمار حياة المرء، وبدلالة «تكوين النشء وتربيته وتهذيب ذوقه» سواء بسواء. وكان لفظ Paiedeia قد اشتق من لفظ Paisالذي أفاد معنى الطفل -لا الصغير بإطلاق صغير الحيوان بما تقتضيه تنشئته من غذاء ونماء- وإنما الصغير بتعيين؛ أي صغير البشر، وذلك بحيث يتعلق الأمر -أمر تثقيفه- بإعداد بدنه وتهذيب نفسه على حد السواء (ومن هنا إشارة أفلاطون الدائمة إلى «تهذيب خلق النشء»، وإشارة أرسطو إلى «البيديا» من حيث هي وسيلة تحقيق: تعريف الإنسان بما هو الكائن الحي الذي وهب النطق والعقل Logos. فلا إنسان يصير إنسانا اللهم إلاَّ بالتهذيب والتشذيب، والتشكيل والتكوين، والتنشئة والتثقيف Paiedeia، لا الطفل ولا المرأة ولا العبد. والذي عنده أن طبيعة الإنسان إنما هي ثقافته على الحصر، إنما الطبع تطبع، وليس يكون استكمال الإنسان لطبيعته إلاَّ بتمام تثقيفه). هو ذا طراز الإنسان لدى الإغريق. وهو الطراز الذي نسج على منواله الألمان المحدثون، وليس على الطراز الروماني نسجوا.
وعند الرومان -على نحو ما ألمعنا إليه في ما تقدم- اشتق لفظ «الثقافة» من الدال اللاتيني Colere بدلالة «سكن وقطن وفلح الأرض وتعهدها». فقد حكم الفعل، عندهم، صلة البشر بالطبيعة (الفلاحة)، مثلما حكم صلتهم بالآلهة (العبادة). ووجه الصلة بين الدلالتين أن البشر إنما شأنهم أنهم يتعهدون الأرض بالفلاحة، كما يتعهدون الآلهة بالعبادة، وذلك كله تلقاء أن تتعهدهم الآلهة بالحماية والرعاية(2). ثم إن ثمة مماثلة بين تعهد الأرض بالفلاحة وتعهد العقول بالثقافة، كلاهما تثقيف. إنما شأن تثقيف بني البشر كشأن تثقيف الأرض، وإنما مثال العقل البشري كمثال الحقل ليس يزهر وليس يثمر إلاَّ متى ما هو تُعُهِّدَ؛ أي ثُقِّفَ. ولربما لهذا الأمر قال حكيم روما شيشرون: «إنما الفلسفة فلاحة (ثقافة) الروح « مثلما الزراعة فلاحة الأرض. وقد علقت المفكرة السياسية الألمانية حنة آرندت على هذا الأمر بالقول: «إنما ظهر مفهوم «الثقافة» وسط شعب فلاح بالأولى، والدلالات الفنية التي أوحى بها والتي يمكن أن تكون قد ارتبطت بهذه الثقافة إنما تتعلق بهذه الوشيجة والعلاقة النفيسة بين الشعب والطبيعة». وقد حاولت هذه المفكرة تفسير سبب غياب مقابل للفظ «الثقافة» عند الإغريق، فأنشأت تقول: «والسبب في عدم وجود مفهوم إغريقي مقابل لمفهوم الثقافة عند الرومان هو غلبة فنون الصناعة في الحضارة الإغريقية، فبينما كان الرومان يميلون إلى اعتبار الفن نفسه ضربا من الزراعة، زراعة الطبيعة، كان الإغريق يميلون إلى اعتبار الزراعة نفسها جزءا لا يتجزأ من الصنع، تابعة للحيل البارعة الحاذقة، حيل«التقنية» التي يروض بها الإنسان، أكثر الكائنات جبروتا، الطبيعة ويحكمها. وما نعتبره نحن، الذين ما زلنا تحت سحر التراث الروماني، عملا طبيعيا جدا ومن أهدأ الأعمال الإنسانية؛ أي حرث الأرض، كان الإغريق ينظرون إليه على أنه عمل يتصف بالجرأة والعنف، وينطوي على إزعاج الأرض التي لا تنفد ولا تتعب والاعتداء عليها عاما بعد عام»(3).
هذا وقد لاحظ البحاثة الألماني جيجر Jaeger في كتابه عن تكوين الإنسان الإغريقي أن الألمان كانوا -من بين الشعوب الأوربية كافة- الوحيدين الذين استعادوا في العصر الحديث الدلالة الإغريقية للثقافة، فكان أن عبروا عنها بلفظ غير اللفظ اللاتيني Cultura، هو لفظ Bildung... وكان أن خص هذا اللفظ للدلالة على ضرب من فن التربية من حيث هو، بحسب استعارة أفلاطون، تشكيل للطبع تشكيلا. وبهذا استعاد اللفظ الألماني الدلالة الأفلاطونية «للبيديا» بمعناها الإغريقي؛ إذ أفاد معنى التشكيل الفني -تشكيل الفنان لأنموذجه- مثلما أفاد تشكيل عقول النشء بوفق أنموذج أو طراز. ومن شأن المشرع هنا -حسب أفلاطون- أن يشكل لا المنحوتة، كما يفعل الفنان، وإنما أن يشكل «الإنسان الحي».
- 3 -
في أصول مفهوم «الحضارة»:
لربما كانت «الحضارة» قديمة قدم التجمعات البشرية الأولى، لكن كلمة «الحضارة»، من حيث دلت هي على اصطلاح مخصوص، كلمة حديثة بحداثة مذهلة تكاد لا توازيها إلاَّ حداثة المجتمعات الغربية نفسها. إذ تعود، بوفق أبعد تقدير ممكن، إلى قرن وصنف خليا (النصف الثاني من القرن الثامن عشر)، بحيث لا تكاد تعثر لها على أثر، بحسب دراسة كان أفردها مؤرخ الحوليات الفرنسي الشهير لوسيان فيفر Lucien Febvre إلى الكلمة - «الحضارة: اللفظ والمعنى»(1930)- قبل سنة 1766م(4). ثم إن عالم اللسانيات الفرنسي إميل بنفنيست Emile Benveniste حفر أكثر، فعاد بها عشر سنوات من ذي قبل، إلى سنة 1756م(5). وقد عثر لها عن استعمالات عند المفكر الفرنسي ميرابوMirabeau (1715-1789) - في مخطوطة من أقدم النصوص التي شهدت على بدء تداول لفظ «الحضارة»: «إذا ما أنا سألت أغلب الناس في أي أمر تتجلى الحضارة عنده؟ لأجابني إنها تتجلى في تهذيب الخلق، وفي التمدن، وفي التأدب، وفي نشر المعارف بحيث تراعى رسوم التهذب... على أن هذا كله ليس يعني عندي إلاَّ قناع الفضيلة لا وجهها الأحق، إنما الذي عندي أن الحضارة ليست تعود بفائدة على المجتمع ما لم تكسبه أساس الفضيلة وشكلها». بهذا تصير الحضارة قلبا لا قالبا ولبا لا قشورا، تصير تعني التهذيب الذي يدفع الفرد والمجتمع إلى مراعاة رسوم التأدب والتخلق والتمدن. وحفر العلامة المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل Fernand Braudel أعمق، فعاد بكلمة «الحضارة» إلى حوالي 1732م ليجد اللفظ إنما عنى، أولا، «التمدين»، بمعناه الحقوقي؛ أي تصيير حكم محاكمة جنائية إلى محاكمة مدنية، وما اكتسب معناه الحديث إلاَّ سنة 1752م مع المفكر الفرنسي تيرغو Turgot (1727-1781) الذي كان يعد العدة لإصدار كتاب حول التاريخ الكوني أورد فيه اللفظ وما كتب له أن ينشره بنفسه(6).
ومهما تصرفت الأحوال، فإن لفظ «الحضارة» صار يعني عند ميرابو -الذي أسهم أكثر من غيره في تداول اللفظ- دلالة «التحضر»، ويقابل دلالتي «التوحش» و«البربرية». وهي الدلالة التي سيورثها ميرابو أسلافه من متأدبة ومفكرة فرنسا وغيرها. ومن هنا صرنا إلى المقابلة الشهيرة بين دلالة «التحضر» و«التوحش»، وقد عني بالتحضر التأنس، وعني بالتوحش التبدي؛ بمعنى البربرية والهمجية والوحشية. بما أفاد إعطاء دلالة حالة «التمدن» -أو المدنية- دلالة الحضارة. فصرنا بهذا، من جهة، أمام الشعوب المتحضرة، ومن جهة أخرى أمام الشعوب المتوحشة أو البدائية أو البربرية، وما كان ليقال عن «المتوحشين الطيبين» -القريبين من قلوب بعض الفلاسفة من أهل القرن الثامن عشر الميلادي (بعض فلاسفة الأنوار)- بأنهم «شعوب متحضرة». قال مؤرخ الحضارة الفرنسي غيزو: «الظاهر عندي أن فكرة التقدم، فكرة التطور، هي الفكرة الأساسية المتضمنة في كلمة الحضارة».
وقد تساءل بنفنيست: إذا ما كان معنى «الحضارة» معنى قديما، فَلِمَ يا ترى تأخر ظهور اللفظ؟ فكان أن رجح سببين: أولهما اشتقاقي بحيث سادت، على ذلك العهد، قلة اشتقاق ألفاظ تنتهي بالخاتمة Isation على نحو Civilisation. فكان لا يوجد لألفاظ Poli و Policé و Civil وCivilisé (بمعنى المهذب الظريف المتأنق..) اسم ولا يشتق منها رسم، أما لفظ Police فقد كانت له دلالة اجتماعية خلقية حصرية. إذ كان «التحضير» هنا يعني تهذيب الخلق وجعله متمدنا اجتماعيا. وثاني السببين تعلق بطبيعة المجتمعات القديمة وسكونها وجمودها بينما المفهوم -التحضر أو التحضير- دل على فعل التجدد. وإذ بدأت تشهد المجتمعات الغربية على تبدلات تطرأ، وإذ هي صارت سيالة بدالة، ضاق اللفظCivilité -الدال على حال الجمود- عن المعنىCivilisation الدال على حال الحراك. فكان أن احتيج إلى تسييل المعنى وتصيير الدال وتحريك الاسم. وإذ كانت دلالةCivilité الجامدة هي الشائعة إلى أن تم تسييلها وتصييرهاCivilisation، فقد دل هذا الأمر على تبدل النظرة إلى المجتمع، وذلك بحيث صير إلى تصور متفائل: مجتمعات تسير على الدوام المطرد نحو التقدم(7). وقد عبر بروديل عن هذه الفكرة بالقول: «لقد بزغت الكلمة لأنه احتيج إليها آنذاك»(8)..
والحال أن اصطلاح «الحضارة» هذا -ذا الميسم الفرنسي البدي- اصطلاح رحال شديد التجوال. فقد حزم حقائبه وصار إلى جولة بدول أوروبا، على أن الرحلة ما تمت بلا عوائق تذكر. فقد أدخل اللفظ إلى بريطانيا Civilization حوالي سنة 1772م أو قبل بقليل، وكان له أن انتصر على لفظ Civility القديم. وكد الكد كله وجهد الجهد أكبره بغاية الدخول إلى ألمانيا أمام تشبث الألمان بلفظ Bildung الذي أبدى مقاومة وعنادا لم يوجد له من نظير ولا من مثيل في تاريخ المفاهيم. وكذلك كان الأمر مع بلاد هولندة أمام لفظ Beschaving الذي اشتق من الفعل beschaven الذي يفيد معنى التهذيب والتنبيل والتمدين، إلى أن تركت بعض الفسحة لتداول لفظ Civilisatie. وكذلك كان الحال مع اللسان الإيطالي أمام غريم قوي شديد الأيد واسع التداول أبي متمنع حصين هو لفظ Civilità الإيطالي الشهير.
وهكذا كان للمفهوم تاريخ موازي في اللسان الانجليزي مشابه لتطوره في اللسان الفرنسي من حيث التأخر في الظهور والدلالة على الصيرورة بالتمام والكمال. فقد استعمل اللفظ سنة 1772م، لا بل سنة 1759م بحسب ما ذكره لوسيان فيفر وتبعه فيه إميل بنفنيست، إذ يذكر «المعجم الإنجليزي الجديد» أن أول استعمال للفظ «الحضارة» كان عام 1772م، فقد نقل من حوار بين العالمين المعجميين بوسويل Boswell وجونسون Johnson ما يلي: «في يوم الاثنين 23 من شهر آذار عام 1772م، دخلت عليه (يعني على الدكتور جونسون صاحب المعجم الشهير) فوجدته عاكفا على إعداد الطبعة الرابعة من معجمه... وما كان هو ليتقبل في هذا المعجم كلمة Civilization وإنما لفظ Civilityوحسب؛ أما أنا فقد خالفته الرأي وملت إلى الاعتقاد بأن لفظ Civilization إنما اشتق من الفعل To civilize؛ فأولى أن يكون عارض لفظ barbarity من أن يكون قابل لفظ Civility وأجدر أن يكون لكل معنى لفظ مخصوص به متميز عن غيره من أن يكون ثمة لفظان والدلالة واحدة كما درج الأمر على ذلك». فإذن، كان للفظ معنيان: الحضارة بمعنى التهذب وآداب الكياسة ورسوم اللياقة -وهو معنى معهود- والمفهوم الثاني غير المعهود هو الذي تقابل فيه والهمجية والبربرية. هذا إلى أن صار اللفظ معهودا في كتابات آدم شميت (1776)، بل حتى قبل ذلك بخمس سنين في كتابات جون ميلر، بل حتى لدى آدم فرجسون أستاذ الفلسفة الأخلاقية في كتابه عن تاريخ المجتمع المدني (1767).
على أنه يبدو أن لفظ «الحضارة» ما استعمل في اللسان الألماني إلاَّ بعد تلكؤ طويل، بعد أن أشاعه الفرنسيان ميرابو وكوندورسي، وأنه بقي في اللسان الألماني دخيلا غريبا ذا أصل فرنسي مريب. ومن هنا أشكال سوء الفهم التي رافقته وأثرت على علاقته بدلالات ألفاظ قريبة منه.
- 3 -
في التباس الصلة بين «الثقافة» و«الحضارة»
لطالما رافق لفظ «الثقافة» لفظ «الحضارة» في مساره وتداوله. لكن في يوم من الأيام -كما يقول بروديل- دعت الضرورة إلى الفصل بينهما فصلا(9). وهو فصل ظل على الدوام أمرا إشكاليا بل وشديد الإشكال.
كتب العلامة النفسي النمساوي سيغموند فرويد عام 1929م كتابا تخير له من العناوين العنوان التاليas Unbehagen in der Kultur. وقد تحير المترجمون الفرنسيون، بأشد حيرة تكون، في ترجمة الكلمة الأخيرة من عنوانه: ترى أيتعلق الأمر بقلق في الثقافة؟ أم يتعلق بقلق في الحضارة؟ وقد كانت الترجمة الفرنسية الأولى رجحت إعمال لفظة «الحضارة» على لفظة «الثقافة»(1934)، لكن سرعان ما استُشكِلَت.
والحقيقة أن هذه الحيرة إنما نمت عن مشكلة أعمق هي مشكلة رحلة المفاهيم من ثقافة إلى أخرى، ومشكلة الترجمة أو النقل، ومشكلة روح حضارتين متباينتين، على الرغم من انضمامهما إلى تقليد حضاري واحد، هو التقليد الأوروبي الغربي.
إن استعمال فرويد لهذا الاصطلاح Kultur في عنوان كتابه ليمتح من التقليد الألماني. فإن بعض مفكرة ومؤرخة ألمانيا، ومنهم ماينكه Meinecke على سبيل المثال لا الحصر، ذهبوا إلى الإشارة إلى الثقافة بكونها القيم الروحية التي ترفع الإنسان فوق مستوى الحياة الحيوانية. وبالمثل، يفيد لفظ «الثقافة»، حين يرد على لسان فرويد، «دلالة جوانية» تتعلق باستبطان الفرد لآليات الاندماج داخل جماعته، واستدخاله لضوابط الجماعة ورسومها وموانعها ومحرماتها وتصييرها له جزءا من ذاته، واستئلافها في روعه واستئناسها في نفسه؛ وهو يفيد، في الوقت ذاته، «دلالة برانية» متعلقة بالآلية التحضيرية التي تعتمد عليها المجتمعات في تأنيس نفسها. فهو بهذا المعنى يراد به مجموع الأعمال والتنظيمات التي تعمل بها المؤسسة على إبعاد نفسها عن حال الحيوانية الأولى. فمن شأن الثقافة، بوفق هذا المعنى، أن تحمي الإنسان من الطبيعة، من جهة أولى، وأن تنظم العلائق بين الناس، من جهة أخرى. وبالجملة، إن الثقافة لهي ما يسمح بإعمال آلية تسامي الدوافع، ولهي ما يمنع الهو من أي ينشر نوازعه القتالة. والحال أن هذا المعنى أثار إشكال نقله إلى الفرنسية: ترى أيتعلق الأمر بالثقافة أم بالحضارة؟
وقد نقض اللساني والمفكر اليميني Edward Pichon (إدوارد بيشون) عام 1937م كتاب فرويد هذا بكتاب سماه «ارتياح في الحضارة» A l’aise dans la civilisation. والحال أنه كان لدلالة «الحضارة»، في قول بيشون، معنى آخر، فهي تفيد تقدم دواعي الخير (التحضر) ضد نوازع الشر (التوحش). والحقّ أن كتاب بيشون هذا كان يستهدف -من وراء ظهر فرويد- فكر الأنوار. إذ لئن هي كانت بعض فلسفات عصر الأنوار قد وضعت -من جهة أولى- مسألة «الحضارة» في صلب اهتمامها -ومن ثمة عدت فلسفة حضارة- فإنها ركزت، من جهة أخرى، على «الاختلافات الثقافية»(ومن هنا أسطورة المتوحش الطيب لدى روسو مثلا)، فكان أن جمعت بذلك بين متناقضين: كانت -من وجه أول- فلسفة كونية تؤمن بتقدم البشرية (الحضارة)، وكانت -من وجه ثان- معادية للكونية تدعو إلى العودة إلى الأصول وتعلي من شأن النماذج الثقافية المختلفة (الثقافة). أما بيشون -وهو الذي متح من خطاب اليمين الفرنسي- فقد دافع عن فكرة «الحضارة»، وأعملها بمعنى «المعقولية» ضدا على فكرة «الثقافة»؛ بمعنى الجوانية الروحية. وبهذا، فإنه لا حرج إذن في الحضارة ولا قلق ولا انزعاج، إنما الحرج والانزعاج والقلق كله واقع في الثقافة. ومن هنا مهاجمته لفرويد(10).
والحقّ أن وراء هذا الخلاف حساسية فكرية عميقة بين الفرنسيين والألمان. إذ للفظ «الحضارة»، في اللسان الفرنسي، دلالة مزدوجة: فهو يشير إلى القيم الأخلاقية والمادية معا. ففي إشارة أولى، كان العلامة الفرنسي شارل سينوبوسCharles Seignobos عادة ما يحب أن يمزج بالقول: «الحضارة هي الطرق والموانئ والأرصفة»، قاصدا بذلك أنها ليست تدل -فحسب- على منتوجات الفكر أو الروح، من أعمال فنية وفكرية وروحية وغيرها، وإنما تفيد -بالأولى والأجدر والأحق- دلالة المنتوجات المادية أيضا. ولقد كان المؤرخ الفرنسي أوجين كافنياكEugène Cavaignac يقول: «إنما الحضارة حد أدنى من العلم والفن والنظام والفضائل». ههنا طبقتان سعى البعض إلى جعل السفلى منهما -المادية- هي ودلالة «الحضارة» سواء، وإلى جعل العليا -المعنوية أو الروحية- هي و«الثقافة» سواء(11).
على أن المشكلة أن التوافق لم يحصل بحيث هيمن لفظ «الحضارة» في فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما استبد لفظ «الثقافة» بألمانيا وبولونيا وروسيا.
يمال بالعادة في ألمانيا إلى تحميل لفظ Kultur دلالة الأمر المتعلق بالفرد (تكوين الفرد) وبالضد إلى تحميل لفظCivilization دلالة الشأن المتعلق بالجماعة. ومما يزيد الطين بلة أن يضاف إلى هذين المفهومين لفظ Bildung أو التكوين الشخصي -التثقيف- بمعنى تهذيب النفس وتشذيب الروح. وقد تحدد لدى فلهلم هامبولت، مثلا، التمايز بين «الحضارة» و«الثقافة» و «التكوين». فبالحضارة يفاد كل ما في النظام المادي وفي العوائد والتنظيم الاجتماعي يسعى إلى تأنيس الإنسان تأنيسا. أما الثقافة فتضيف دلالة التهذب والتأنق في المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسعى والمزين... أي ما به يرتفع الإنسان عن مجرد إشباع حاجاته المباشرة إلى طلب الترفه ونعومة العيش ولذاذته. لكن أعلى منه «التكوين» الذي يفي استكمال الفرد تهذبه الفكري والخلقي، وهو ما لا يبلغه إلاَّ القليل من الناس وأقل القليل. وعلى وجه التدقيق، يمال في اللسان الألماني إلى تضمين لفظ Kultur الشعر والشعور الديني والإحساس الشخصي والعمارة والموسيقى والعلم، بينما يمال، بالضد، إلى تضمين لفظ Civilization، الدخيل على اللسان الألماني، دلالة المظاهر الخارجية -وليس الجوانية الداخلية- لوضع ثقافي معين(12). وبه يتضح أنه ما كان للتقابل بين لفظي «الحضارة» و«الثقافة»، في اللسانين الألماني والفرنسي، نفس المضمون التاريخي، لا ولا كانت له الدلالة الإيديولوجية عَينُها.
ومما طَمَّ الوادي على القرى أنه في فلسفة عصر الأنوار -كما ألمعنا إلى ذلك في ما تقدم- أطلق لفظ «الحضارة» لكي تتعين به المنزلة التي بلغتها الشعوب من التهذب، وقد خرجت من حال الطبيعة، بينما دل لفظ «الثقافة» على القيم والممارسات التي احتفظت بها من هذه الحال. ولقد حدث أن استعاد أنتربولوجيو القرن العشرين هذه الدلالة وقرنوها بمفهوم «الاختلاف». وهكذا، فبينما الشأن في «الحضارة» أنها توحد وتشرع بإدخال فكرة «تقدم العوائد»، فإن الأمر في «الثقافة» أنها تخالف وتشمل المهمشات؛ بما أكسبها دلالة معادية للتمركز الاثنولوجي على الذات (المركزية الغربية)، وبالتالي دلالة صدامية مع مفهوم «الحضارة» الموغل في مركزيته وعليائه. ومما زاد الأمور لبسا ليس وراءه لبس دخول علماء الأنتربولوجيا الإنجلوسكسون على الخط، بدءا من تايلور(Primitive culture, 1874) G.B Taylor لما أرادوا توصيف المجتمعات البدائية بإعمال وسم يخالفون به وسم «الحضارة» الذي كان يستعمله اللسان الإنجليزي في توصيف المجتمعات الحديثة؛ فكان أن اهتدوا إلى مفهوم «الثقافة» -لا سيما في صيغته الجمعية: «الثقافات» - مقابلين بين «الثقافات» البدائية و «حضارة » أو «حضارات» المجتمعات الحديثة.
والحال أنه يعود استعمال كلمة Kultur، في اللسان الألماني إلى القرن الثامن عشر. وقد اتخذ هذا اللفظ، في نهاية ذاك القرن، دلالات ثلاث: 1- الحالة الاجتماعية، المعارضة لحال بربرية الشعوب الهمجية، بما دل عليها تطور استعمال الأدوات والرفاه المادي والتنظيم السياسي. 2- تحرر العقل الحديث من ظلمات الماضي وآرائه الاعتباطية (التنور). 3- تهذب العوائد وتشذب الشمائل(13). وهي الدلالات التي شهدت عليها كتابات أبرز كتاب ألمانيا على ذلك العهد. هذا هردر يتصور تبدي «الثقافة»، على التدرج، في أربع مراحل من تطور البشرية: تأنيس بعض الحيوانات التي كانت في البدء غير أهلية، وفلاحة الأرض، وتطوير التجارة والعلوم والفنون (الثقافة في دلالتها المتداولة العادية)، وإقامة أنظمة حكم وإيالة جيدة (وهي عنده أصعب فنون الثقافة على الإطلاق). وهذا كانط بدا عنده أن من شأن الثقافة أن تعارض البربرية، وأنه في اليوم الذي يكف فيه بنو البشر عن التقاتل يشرعوا فيه -في الوقت نفسه- في إقامة الثقافة. على أن الثقافة الحقة تقتضي قطع أشواط بعيدة يصير فيها القانون -وليس الهوى- هو ما يحكم العلائق بين بني البشر فرادى وجماعات. وعند شيلر تقوم الثقافة، سلبا، على محاربة الجهالة الجهلاء، وعلى التحرر من الآراء الاعتباطية، وعلى التخلص من الفظاظة والغلظة والعصبية والوحشية؛ وتقوم، إيجابا، على التسامح والتنور. هكذا يكون «فجر الثقافة» لدى الأمم، هو -في الوقت ذاته- الطريق نحو التحضر Civilisierung. هذا ولئن هي بدت الثقافة «خيرا مشتركا» بين الناس أجمعين لكل أمة منه نصيب، و «أعدل قسمة» بين الشعوب كافة كل له منها حظ، فإنه، بدءا من جوته وانتهاء بالرومانسيين الذين تلوه، سوف تصير «الثقافة» ميزة لدى بعض الأمم ومزية، شأن الأمة الإيطالية مثلا، وقد زارها جوته ولاحظ أوجه اختلافها وتميزها عن بقية أمم أوروبا الأخرى، ووسم هذا التميز بميسم «الثقافة». كذا فعل أيضا ألكسندر هامبولت لما نظر على «الثقافة» كما لو كانت هي من الخيرات الوطنية التي شأنها أن تمتلك وتنقل وتموت. وبهذا استحالت «الثقافة» التعبير عن أنماط عيش شعب ما، وعن أنحاء تفكيره، وعن ألوان إحساسه. وبدءا من هذا أيضا، سيتم الانتقال من كونية الكلاسيكيين الألمان إلى قومية الرومانسيين: هذا فيشته في خطاباته إلى الأمة الألمانية -على سبيل المثال- يربط «الثقافة» بالوطن، ويجعل من الثقافة الألمانية الأعلى بين الأمم. مِمَّا مهد السبيل إلى رانكه للتمهية بين «الثقافة» و «الوطنية».
وبالجملة، لقد بدا وكأن تطور دلالة لفظ «الثقافة»، بألمانيا، يخضع إلى القانون التالي: «كلما تقدم الزمن بالمفهوم مال إلى أن يتخصص»(14). إذ بالنسبة إلى كتاب العصر الكلاسيكي، اتسع المفهوم لكي يشمل مظاهر التقدم، المادي والفكري والخلقي، التي حققتها البشرية معتبرة في جملتها. أما بالنسبة إلى تابعيهم، فإن المفهوم ضاق بأشد ضيق يكون فصار يدل على جملة إنجازات فكرية وقد عدت «خيرا خاصا» بأمة بل ومخصوصا بها موقوفا عليها دون سواها.
وهكذا فإنه في ألمانيا -وبعد لحظة تأرجح وضبابية- لعبت التفرقة بين دلالة «الثقافة» Kultur ودلالة «الحضارة»Civilization دورا شديد الأهمية. فقد أعطيت الأولوية -وعلى خلاف باقي التقاليد الفرنسي منها والإنجليزي والأمريكي وغيرها- إلى مفهوم «الثقافة». وهكذا، فإنه بالنسبة إلى عالمي الاجتماع الألمانيين الكبيرين فردناند طونيز (1922) Ferdinand Tonnies وألفريد فيبر (1935) Alfred Weber، فإنه ما كانت «الحضارة» إلاَّ جملة المعارف التقنية والعملية -إنها جماع وسائل الفعل في الطبيعة والتأثير عليها- أما «الثقافة» فهي: المبادئ المعيارية والقيم والمثل؛ أي ما يدعوه الألمان باسم «الروح» Geist. لنقل إن الأولى تقابل -بلغة قدمائنا- «الأواني»، والثانية تشاكل «المعاني»، والسابقة تحيل على «الجسد» واللاحقة تخص «الروح». ولعل هذه المواقف هي ما يفسر فكرة المؤرخ الألماني فيلهلم مومسن (1951) Wilhelm Mommsen الغريبة على التقاليد الأخرى في النظر إلى مثنوية الحضارة/الثقافة لما هو قال: «من واجب الإنسان اليوم أن يمنع الحضارة من أن تدمر الثقافة، وأن يمنع التقنية من أن تدمر الكائن البشري». أَوَ ليست الحضارة -كما قال ماينكه- شكل بلا روح؟
وما كان اقتصر الأمر في هذا الاستعمال العجيب لثنائية: الحضارة/الثقافة على أهل النظر من الألمان وحدهم، وإنما تجاوزه إلى أهل الأدب. هذا الروائي الألماني الشهير توماس مان كان قد كتب نصا -ظل مجهولا لعقود من الزمن وتحرج صاحبه منه فلم يعد نشره فيما بعد- سنة 1914م -والجو المخيم على أوروبا جو حرب- تحت عنوان «أفكار في الحرب» ألح فيه على إجراء التفرقة بين «الحضارة» و«الثقافة» قائلا: «كلا، ما كانت الحضارة والثقافة بالأمر عينه، وإنما هما -على الضد- خصمان، خصمان يشكلان أحد وجوه مختلف تجليات الصراع الأبدي الكوني والتعارض بين الروح والطبيعة. فليس من أحد ينكر، مثلا، أنه كانت للمكسيك ثقافة زمن اكتشافها، ولكن ليس من أحد بالمقابل يؤكد أنها كانت ذات حضارة على ذلك العهد. فما كانت الثقافة، بكل تأكيد، نقيض البربرية، وما هي -على الأغلب- إلاَّ وحشية ذات أسلوب كبير. ومن بين الشعوب القديمة كان الصينيون من دون شك، وحدهم أصحاب حضارة. ما تعنيه الثقافة إنما هو الانسجام والأسلوب والشكل والتعهد والذوق، وتنظيم ذهني معين للعالم، عدت هذه الأمور مضحكة ومتوحشة ودموية ومرعبة ما عدت وحسبت كيف حسبت». والذي يصح عنده أنه: «يمكن للثقافة أن تعني العرافين والسحر واللواط والعفاريت والشياطين والأضحيات البشرية والعبادات الجنسية الجماعية ومحكمة التفتيش وإحراق الكتب ورقصة سان غي، ومحاكمة المشعوذات وازدهار التسميمات ومختلف ألوان الفظاعة. ذلك بينما الحضارة هي العقل والأنوار والتأدب والتهذب والشك -هي ذي الروح. أجل، الروح متحضرة بورجوازية، وهي معادية للشيطنة ومعادية للبطولة، وإنه ليبدو محالا -من حيث الظاهر فحسب- القول: إنها أيضا معادية للعبقرية، أما حقيقتها فهي كذلك». ومن ثمة كان للفظ «الثقافة»، عنده، حقل دلالي مباين لحقل دلالة «الحضارة»: «السياسة من شأن العقل والديمقراطية والحضارة، بينما الأخلاق من شأن الثقافة والروح»، ومن هنا تأتي دعوته إلى تطهير العالم الأوروبي من الجرثومة التي تهدم الروح- من «جراثيم الحضارة». والحقّ عنده أنه: «ما كان الألمان -عن حق- مأخوذين بكلمة «الحضارة»، على خلاق ما هو الحال عليه لدى الأمم الغربية جارتهم، ولم يعتادوا على إشهار هذا اللفظ وكأنه راية، على الطريقة الفرنسية، لا ولا الابتدار إلى جعله نفاقا وعقيدة، كما لدى الإنجليز. لقد فضلوا دوما إعمال كلمة ومفهوم «الثقافة». لماذا إذن؟ (..)؛ لأنَّ هذا الشعب الأكثر أوبة إلى نفسه وانكفاء عليها من غيره، هو شعب الميتافيزيقيا والبيداغوجيا والموسيقى، ما كان له ميل إلى السياسة، وإنما ميله إلى الأخلاق بارز (..) وإن الروح الألمانية لمن العمق بمكان بما من شأنه أن يمنع من أن تظهر لها الحضارة كما لو كانت هي العليا بله الفكرة الأسمى». هذا لكي يخلص إلى حد القول: «مجدف هذا الذي يحظر على باله أن يتمنى أن تختفي الأمة الألمانية من على وجه البسيطة لكي تترك المكان للإنسانية وللعقل»(15).
بالتوفيق للجميع
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا

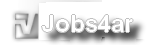




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

