مقال السوسيولوجي: نظرية العنف الرمزي عند بيير بورديو
منتدى الفلسفة وعلم الاجتماع:- مقال السوسيولوجي: نظرية العنف الرمزي عند بيير بورديو
لتعريف بعلم الإجتماع
يؤكد »ريمون آرون « أحد المشتغلين بعلم الإجتماع في فرنسا أن علم الإجتماع يتميز بأنه
دائم البحث عن نفسه , وأن أكثر النقاط اتفاقا بين المشتغلين به هي صعوبة تحديد علم الإجتماع كما
أورد »بيتروم سروكين «في مؤلفه »النظريات السوسيولوجية ا لمعاصرة « عام 1928 آراء أكثر من ألف عالم وباحث في علم الاجتماع ,الأمر الذي يجعل من الصعوبة تحديد من نجح منهم في تعريف علم الإجتماع ومع التسليم بوجود تباينات كثيرة ارتبطت بتحديد العلم وموضوعه , فهي تباينات فرضتها طبيعة العلم في نشأته وتطوره حيث تأثر بجماع الأطر اﻟﻤﺠتمعية والفكرية التي أحاطت به, بما في
ذلك الدين والفلسفة والعلوم الطبيعية , كما تأثر بطبيعة التغيرات التي طرأت ولا تزال تواصل تأثيرها
على اﻟﻤﺠتمع الإنساني, و بمجمل الظروف الإجتماعية والثقافية التي أحاطت بكل رائد من رواد العلم,
وجعلته ابتداء يرتبط في خبرته بمجتمع دون غيره. زد على كل هذا حالة ا لنهج العلمي في كل فترة من
الفترات التاريخية التي مر بها العلم.
وهذه مؤثرات لم يكن تأثيرها وقفا على علم الإجتماع, أو على أي علم آخر دون غيره من العلوم الإنسانية أو حتى الطبيعية.
والذي يجدر بنا التركيز عليه في هذا المنحى أنه رغم هذه التباينات فإن ثمة نقاطا أساسية
تمثل ولو هيكلا عاما يتحرك من خلاله علم الاجتماع , و يتحدد به موضوعه الأساسي وهو هيكل يشير إلى:
إن علم الإجتماع هو علم دراسة الإنسان واﻟﻤﺠتمع , دراسة علمية, تعتمد على ا لمنهج العلمي ,
وما يقتضيه هذا ا لمنهج من أسس وأساليب في البحث.
وهذا البعد الأساسي في التعريف يعد حصاد تطورات علم الإجتماع منذ أن ولد على يد العلامة العربي
»ابن خلدون « الذي حدده بأنه علم العمران البشري , وما يحويه هذا العمران من مختلف جوانب الحياة الإجتماعية ا لمادية والعقلية ومرورا بأوجيست كونت A.Comte الذي اشتق كلمة sociology من مقطعين من اللاتينية واليونانية ليشير بهما إلى الدراسة العلمية للمجتمع.
أما إضافة »الإنسان « إلى التعريفين اللذين وردا من خلال هذين الرائدين واللذين مازالا موضوع محاكاة كثيرين ممن كتبوا بعدهما , فذلك لأن الإقتصار على ر بط العلم باﻟﻤﺠتمع جعل الكثير من الكتاب والباحثين يكتبون في موضوعات وقضايا أخرى كثيرة ,أضاعت وقتهم , وأخرجتهم عن موضوع العلم وقضاياه , ومن ثم كتبوا في اﻟﻤﺠتمعات الحيوانية وما شابه ذلك من موضوعات , والاهم من ذلك أن التركيز على كلمة »اﻟﻤﺠتمع « وحدها جعلت الكثير من النظريات تنظر للمجتمع نظرة جعلته فوق الإنسان , فأهدرت الإرادة الإنسانية , وطلبت من البشر التكيف مع العالم المحيط , وهم في هذا يكادون يشبهون اﻟﻤﺠتمع بالبيئة الطبيعية.
وقد يرى البعض أن التعريف السابق للعلم وتحديده بدراسة الإنسان واﻟﻤﺠتمع يجعله يتداخل مع فروع أخرى من فروع العلوم الإنسانية وبالتالي يطرح سؤالا:
ما الذي يميز هذا العلم عن غيره من هذه العلوم؟
وبتحليل المحاولات اﻟﻤﺨتلفة التي عنيت بقضية علاقة علم الاجتماع بغيره من العلوم يتبين لنا انه إذا كان كل علم من العلوم الإنسانية يدرس جانبا أو اكثر من جوانب الإنسان أو اﻟﻤﺠتمع , فإن علم الإجتماع يدرس اﻟﻤﺠتمع ككل في ثباته وتغيره , ويدرس الإنسان من خلال علاقته باﻟﻤﺠتمع , أي أنه أكثر شمولا من أي من العلوم الإنسانية . وليس معنى ذلك أن دراسة كل العلوم تعادل دراسة علم الإجتماع, ذلك لأن الواقع الإنساني ليس مجرد جمع بسيط لأجزائه .
وهنا يمكن أن نذكر مثالا تشبيهيا توضيحيا كثيرا ما يتردد لتوضيح الفرق بين علم الإجتماع وغيره من العلوم .
فالمركب الكيميائي للماء يشير إلى تكونه من أيدروجين وأوكسجين لكل خصائصه
ا لمتميزة ,أما عندما يتفاعلان سويا فإنهما ينتجان ا لماء الذي له من الخصائص ما يختلف جذريا عن كل من الغازين ا لمذكورين.
وبنفس منطق المقارنة يدرس كل علم من العلوم الإنسانية جانبا من الإنسان واﻟﻤﺠتمع , كالإقتصاد وعلم النفس… الخ .
أما علم الإجتماع فيدرس حصاد تفاعل العلاقات بين هذه الجوانب من ناحية وبينها و بين الإنسان من ناحية ثانية. وإذا كانت دراسات العلوم الأخرى لا تغني عن دراسات علم الإجتماع, بل تفيد منها ,
فبنفس القدر لا تغني دراسات علم الاجتماع عن هذه العلوم بل هي تفيد منها وتعمق من نتائجها مما يساعد في النهاية على إقامة وحدة فكرية شاملة حول الإنسان واﻟﻤﺠتمع ,
ماضيا, وحاضرا , وتوجها نحو مستقبل مقصود ومرغوب فيه .
و جدير بالذكر أن علم الاجتماع تأثر كغيره من العلوم بظاهرة التخصص التي برزت بصورة واضحة مع انتشار الحركة الصناعية وتقدم البحث العلمي فتشعبت اهتماماته وتعددت ميادينه، وأخذ كل منها يتناول جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية.
و تتحدد ميادين علم الاجتماع وتتعدد تبعاً لنوع المتغيرات الاجتماعية المتنوعة والمتداخلة معها، ولقد
أصبحت الميادين في علم الاجتماع تنوف على ثلاثين ميداناً منها السياسي والبدوي والحضري والريفي وغير ذلك.
ميادين اشتغال علم الإجتماع
يهتم علم الاجتماع Sociology بدراسة المجتمع وما يسود فيه من ظواهر اجتماعية مختلفة دراسة تعتمد على أسس البحث العلمي بغية التوصل إلى قواعد وقوانين عامة تفصح عن الارتباطات المختلفة القائمة بينها.
ويتضح مما سبق أن موضوع علم الاجتماع هو المجتمع الإنساني، وأن ما تطرحه الجماعات الإنسانية من ظواهر ومسائل اجتماعية هي مجال الدراسات الاجتماعية، ويقوم علم الاجتماع بدراسة تلك الجماعات من حيث هي مجموعات من الأفراد انضم بعضهم إلى بعض بعلاقات اجتماعية تختلف عن الفئات الإحصائية التي تشير إلى أفراد لارابط بينهم.
وعلم الاجتماع، من هذا المنظور، يسعى إلى معرفة الحياة الاجتماعية، عن طريق الحصول على بيانات صادقة من الواقع الاجتماعي بوسائل وأدوات تتطور مع تطور العلوم ذاتها، فالعلم مجموعة من المعارف و طريقة للعمل على حد سواء، والظواهر الاجتماعية تخضع للبحث العلمي الدقيق إذا ما اتبع في دراستها منهج علمي يماثل في أسسه ومنطقه ما هو معتمد في مجالات علمية أخرى.
فدور علم الإجتماع المفترض هو اكتشاف شروط إنتاج و إعادة إنتاج ” الاجتماعي ” ، أي التمكن من منطق العلاقات و الأدوار و المؤسسات المجتمعية ، و إضفاء معنى منطقي على حركاتها و سكناتها ،و هكذا مطمح علمي لا يكون إلا باستدماج و استلهام فهم خاص للممارسة السوسيولوجية ، فالبحث عن منطق ” الاجتماعي ” لا ينكتب إلا بتفجير الأسئلة ، ألم يقل بيير بورديو أن مهمة السوسيولوجي هي تفجير السؤال النقدي ؟
فالعصف التساؤلي هو الذي يعبد الطريق نحو هذا المنطق المبحوث عنه ، و هو الذي ينتقل بالباحث من مستوى المقاربات الحدسية إلى عمق الأشياء و شروط انبنائها الأولية ، و يقوده نهاية إلى المهمة التكسيرية للسوسيولوجيا ، و ذلك في مساءلتها الخاصة و النوعية للظواهر و التحولات المجتمعية ، فموضوع السوسيولوجيا كما يقول آلان توران ” ليس ما هو ماثل أمام أعيننا ، بل ما هو مخفي باستمرار.”
مهنة عالم الإجتماع
وهكذا يعالج الباحث في علم الاجتماع الأفعال الاجتماعية ذات المعاني المشتركة، والأشكال التي تتخذها العلاقات المتبادلة في الحياة الاجتماعية، بقصد البحث عن الظواهر والنظم الاجتماعية والكشف عن المبادئ التي تحدد طبائعها، ليصل الباحث الاجتماعي إلى مقارنة البيانات الإحصائية من جوانبها المختلفة وفي أوقات متعددة، وبذا تتضح له معالم الحياة الاجتماعية والوقائع الاجتماعية، ويتعرف النظم السائدة، فيمكنّه ذلك من إصدار الأحكام والقواعد والقوانين العامة التي تخضع لها تلك الظواهر.
و يشير بول باسكون إلى أن ” عالم الاجتماع هو ، و ينبغي أن يكون ، ذاك الذي تأتي الفضيحة عن طريقه ” فالسوسيولوجي وفقا للطرح الباسكوني لن يكون غير مناضل علمي يفكك و يحلل و يدرس كافة التفاصيل المجتمعية من أجل فهم الظواهر و الأنساق ، بما يعني ذلك من قطع مباشر مع التواطؤ و التلاعب ، و ما يعني أيضا من مراهنة أكيدة على الكشف و الفضح المستمر لما يعتمل في العمق من حالات اختلال أو اتساق .
و بذلك تصير السوسيولوجيا أداة علمية للقراءة و الفضح في آن ، تقرأ التحولات الاجتماعية ، و تموضعها في سياقها الخاص قبل العام ، و في ذلك كله فضح و تعرية لشروط الانبناء و الانوجاد ، أليست السوسيولوجيا مجرد علم يبحث في شروط إنتاج و
إعادة إنتاج الاجتماعي ؟
التعريف ببييربورديو
يعد “بيير بورديو” (2002 – 1930) عالم الاجتماع الفرنسي الشهير وأحد أبرز الأعلام الفكرية في القرن العشرين. يحتل مكانة مميزة في حقل الدراسات الإنسانية. شهد علم الاجتماع على يديه إبداعا علميا رائعا، وتجديدا فكريا حقيقيا في المصطلحات والمضامين والدور والأهداف. فقد أحدث الرجل في تحليله للظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية تغييرا في حقل الدراسات الثقافية والأبحاث الاجتماعية النقدية وفي مفهوم علم الاجتماع نفسه. لقد هال الجميع إنتاجه الفكري الغزير والمتميز، واطلاعه الواسع، وإرادته القوية والشجاعة في تطبيق الأفكار والمبادئ التي نادى بها في أعماله الفكرية وتصميمه الحاسم على ترجمتها إلى سلوك ومواقف وممارسات عملية من خلال مشاركاته ومداخلاته الشخصية في المظاهرات والحركات الاجتماعية والسياسية.
كان (بورديو) مفكرا فذا،عالمي الثقافة، وانساني التوجه ومن أبرز المثقفين المناضلين في تاريخ النضال الاجتماعي والسياسي والثقافي في القرن العشرين. لقد انخرط (بورديو) في معمعة الفكر العالمي الجياش وشارك عمليا في حراك مجتمعه وكون لنفسه رؤية خاصة في الشأن الفرنسي خصوصا وفي الشأن الإنساني عموما وراح يكتب بحماس ملتهب وبغزارة جارفة. وقد أكسبته هذه الرؤية العميقة الواسعة وذلك النضال الفاعل مكانة عالمية وجعلته نموذجا رائعا للإقدام في الفكر والفعل.
درس بورديو الفلسفة في مدرسة المعلمين العليا في باريس ونال فيها شهادة الأستاذية في الفلسفة في عام 1954م. وكان (جاك دريدا) الفيلسوف الفرنسي الشهير من الذين تخرجوا في نفس الدورة. أطلع بورديوعلى أعمال (ماركس) (وجان بول سارتر) وفي الوقت الذي كان المذهب الوجودي يطغى على الأوساط الفلسفية، توجه بورديو نحو دراسة المنطق وتاريخ العلوم ثم تابع حلقة دراسية في التعليم العالي حول فلسفة الحق عند هيجل. ولكن، بعد تجربة قصيرة له كأستاذ في إحدى الثانويات، دعي من قبل المكتب النفسي للجيوش في مدينة فرساي ولكن لأسباب تأديبية أرسل بسرعة إلى الجزائر في إطار إحلال السلام حيث أدى هناك القسم الأساسي من خدمته العسكرية. ومن 1958الى1960م تمنى أن يتابع دراساته عن الجزائر. فدرس في كلية الآداب في الجزائر واهتم بالدراسات الأنثروبولوجيية والاجتماعية وكتب بعد عودته إلى فرنسا مباشرة كتابا بعنوان (سوسيولجيا الجزائر). ثم أصدر كتابا آخر بعنوان (أزمة الزراعة
التقليدية في الجزائر). وبدأ يدرس الفلسفة في السوربون ثم أصبح مديرا لقسم الدراسات في مدرسة الدراسات العليا، ثم مديرا لمعهد علم الاجتماع الأوربي، كما انتخب عام 1982م لكرسي علم الاجتماع في «الكوليج دو فرانس»وهي أعلى هيئة علمية في فرنسا. وكانت محاضرته الافتتاحية في «الكوليج دو فرانس» بعنوان “درس في درس” وقد جال فيها بجدارة في ميادين النقد الاجتماعي والسياسي والتربوي والنفسي وختمها بالتحذير من ظاهرة التسامي الزائف التي تنشأ عن إساءة استخدام المعرفة. وهكذا ظل يدرس ويحاضر فيها لغاية عام 2001م.
كان بيير بورديو على موعد مع الشهرة مبكرا بعد إصداره كتاب (الورثة) بالاشتراك مع (جون كلود باسرون) ولكن تألق نجمه مع ثورة الطلاب عام 1968م التي جذبت وركزت أنظار المجتمع الفرنسي ووسائل الإعلام على الجامعة والنظام التعليمي..
ومن المفاهيم الأساسية التي استخدمها بورديو في تحليله: «إعادة الإنتاج» و«الحقل» و«رأس المال الرمزي» و« العنف الرمزي» و«العرف» و«الانعكاسية».
إذا كان بورديو قضى شطرا من حياته في البحث الاجتماعي وتحليل الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد كرس السنوات الأخيرة من حياته المعرفية والعملية في العمل النضالي السلمي والمشاركة السياسية الفاعلة ضد الأشكال الجديدة من السلطة السياسية والاقتصادية.
وأصدر في هذه المرحلة مجموعة كتب قيمة أذكر منها: (بؤس العالم) و(علل عملية. في نظرية الفعل) و(عن التلفزيون) و(تأملات باسكالية) و(السيطرة الذكورية) و(البنيات الاجتماعية للاقتصاد) و(علم العلم والانعكاسية) و(تدخلات.العلم الاجتماعي والعمل السياسي) و(توطئة لتحليل ذاتي).
يرى بورديو أنه ليس جديا أن نفكر في السياسة دون أن نتحلى بتفكير سياسي، ولا يمكن فهم ظاهرة ما دون تحليل بنيتها والآليات التي تحكمها وتعمل وفقا لها. وفي رأيه أن تحليل الواقع الاجتماعي ونقده يساهم في تغييره.
تعود علاقة بورديو بالسياسة إلى فترة حرب الجزائر ويرى الرجل أن العلوم الاجتماعية لا تستحق الاهتمام إن لم تكن في خدمة الإنسان والمجتمع وان لم تكشف آليات الهيمنة السائدة في المجتمع. يقول بورديو في كتاب (إعادة الإنتاج): من المفهوم أن علم الاجتماع كان مرتبطا جزئيا بالقوى التاريخية التي كانت تحدد طبيعة علاقات القوى التي يجب الكشف عنها في كل حقبة من حقب التاريخ. المشكلة السياسية الخاصة كانت تلك المتعلقة بنشر الأعمال العلمية المتقدمة التي تسمح بفهم وتقدير أكثر
ديمقراطية بقدر المستطاع للنتائج التي يتوصل إليها علم الاجتماع (في مقابل البحوث العملية التي تتم حسب طلب الهيئات والمؤسسات الحاكمة التي تستخدم العلوم الاجتماعية من أجل أن تتحكم بشكل أفضل وتهيمن بفاعلية على الخاضعين لهيمنتها). ولم يكن من باب المصادفة صدور كتاب بؤس العالم في عام 1993م قبل الانتخابات الفرنسية.هذا الكتاب الضخم هو ثمرة سنوات من العمل البحثي الكبير الذي شارك فيه عشرات من الباحثين الذين عملوا بالتعاون الوثيق مع بورديو وقد كان الهدف الأساسي منه الكشف عن المعاناة الاجتماعية الناتجة عن سياسة الليبرالية الجديدة . لازلت أذكر شخصيا كيف لاقى هذا الكتاب اهتماما إعلاميا كبيرا في فرنسا جعل من بورديو شخصية عامة ومؤثرة.
ثم اصدر بعد ذلك سلسلة من الكتب تدور موضوعاتها حول قضايا سياسية ساخنة وكان الهدف من ورائها دفع الدراسات التي تقوم بها العلوم الإنسانية إلى ميدان النضال السياسي. ومن أجمل كتبه كتابه الرائع عن التلفزيون. حلل بورديو فيه حالة وسائل الإعلام وهاجم التلفزيون وأعتبره جهازا مدمرا لأنه يستخدم مخزن النظام الرمزي ليشيع خطرا كبيرا في ميادين الإنتاج الثقافي والفني والأدبي والعلمي والفلسفي والقانوني، كما انه يشيع خطرا لا يقل عن ذلك للحياة السياسية والديمقراطية، وكذلك يشيع التفاهة في المشاهدين ويقدم ثقافة سريعة حسب تعبيره.
و لعل من أبرز ما ألف بورديو هذه النفائس: (سوسيولوجيا الجزائر)، و(الورثة.الطلبة والثقافة)، و(إعادة الإنتاج.أصول نظرية في نظام التعليم)، و(التمييزـ التميز.النقد الاجتماعي لحكم الذوق)، و (الحس العملي)، و(ما معنى أن نتكلم.اقتصاد التبادلات اللغوية)، و(درس في الدرس)، (ومسائل في علم الاجتماع)، و(الإنسان الأكاديمي)، و(الانطولوجيا السياسية عند مارتن هيدغر)، و(منطق الممارسة)، و(إجابات. من أجل إنسيات انعكاسية)، و (قواعد الفن)، و(بؤس العالم)، و(علل عملية. في نظرية الفعل)، و(عن التلفزيون)، و(تأملات باسكالية)، و(السيطرة الذكورية)، و(البنيات الاجتماعية للاقتصاد)، و(علم العلم والانعكاسية)، و(تدخلات. العلم الاجتماعي والعمل السياسي)، و(توطئة لتحليل ذات.
تعريف العنف الرمزي
يتحدث بيير بورديو عن العنف الرمزي الذي هو عنف غير فيزيائي، يتم أساسا عبر وسائل التربية وتلقين المعرفة والإيديولوجيا، وهو شكل لطيف وغير محسوس من العنف، وهو غير مرئي بالنسبة لضحاياهم أنفسهم. وينتقد بورديو الفكر
الماركسي الذي لم يولي اهتماما كبيرا للأشكال المختلفة للعنف الرمزي، مهتما أكثرا بأشكال العنف المادي والاقتصادي. كما أشار بورديو إلى أن العنف الرمزي يمارس تأثيره حتى في المجال الاقتصادي نفسه، كما أنه فعال ويحقق نتائج أكثر من تلك التي يمكن أن يحققها العنف المادي أو البوليسي.
و غني عن البيان أن العنف الرمزي يمارس على الفاعلين الاجتماعيين بموافقتهم وتواطئهم. ولذلك فهم غالبا ما لا يعترفون به كعنف؛ بحيث أنهم يستدمجونه كبديهيات أو مسلمات من خلال وسائل التربية والتنشئة الاجتماعية وأشكال التواصل داخل المجتمع. ومن هذه الزاوية يمكن، حسب بورديو فهم الأساس الحقيقي الذي تستند إليه السلطة السياسية في بسط سيطرتها وهيمنتها؛ فهي تستغل بذكاء التقنيات والآليات التي يمرر من خلالها العنف الرمزي، والتي تسهل عليها تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وبفعالية أكثر، خصوصا وأن هناك توافقا بين البنيات الموضوعية السائدة على أرض الواقع وبين البنيات الذهنية الحاصلة على مستوى الفكر.
هكذا يتبين أن العنف يتخذ شكلين رئيسيين؛ الأول هو العنف المادي و مظاهره المختلفة، والثاني هو العنف الرمزي الذي بين بورديو بعض وسائله ومدى فعاليته في تثبيت دعائم الدولة والسلطة السياسية. من هنا يبدو أنه من المستحيل الحديث عن مجتمعات إنسانية خالية من العنف؛ فهو ظاهرة أكيدة في تاريخ المجتمعات البشرية.
ومن الجدير ذكره، أنه بالإمكان تهديم شخص ما من دون أن يلاحظ المحيطون به هذا الأمر، عن طريق الكلمات البريئة ظاهرياً أو الإشارات أو الافتراضات أو مجرد الإبعاد.
هذا العنف (الخفي) لكن المتكرر، المزمن وأحياناً اليومي، الذي يصيب نفسية الإنسان ليس جسده بالإرهاق الشديد والألم الذي يعاني منه غالباً بصمت والذي يقوده بالتالي إلى الانكماش والانكفاء نحو الذات، قاتلاً فيه ومقصياً أفضل طاقاته وإبداعاته، مما ينسحب بالتالي إلى طريقة تعامله مع محيطه الصغير أو الكبير، والى عدم التحسب لردود أفعاله
التي تتسم غالباً بسمات الطيش والتهور مفضية بالتالي به وبغيره إلى دوامة التطرف والعنف.
فبرأي بيار بورديو، العنف الرمزي هو عنف هادئ، غير مرئي ومقّنع. (لكونه غير معروف بهذه الصفات، فقد نختاره بقدر ما نعانيه). هكذا فهو يميز فرض التراتبيات في المعارف المشروعة، والأذواق الفنية، وأصول اللياقة، الخ. هذا التعريف لا يأخذ إذاً في اعتباره التجربة الذاتية لمعاناة الفرد. ولكن توجد ظواهر سياسية عديدة، كبيرة الأهمية، ترتبط بشكل آخر من العنف الرمزي تسهل ملاحظته، أي الذي ينتج عن إيذاء تقدير الذات أو التمثيلات الجماعية للذات، فيشكل مصدراً لتراجع الهوية. هكذا مثلاً الخطابات المعادية للأجانب والعنصرية، أو أيضاً إظهار ألقاب التفوق التي تعتبر غير مشروعة (الاستعلاء الأرستقراطي عشية الثورة الفرنسية، الوطنية المتعصبة، إيديولوجيات الشعب المختار أو الطبقة الحاكمة).
و لقد عمل بورديوعلى انتقاد تغاضي الماركسية عن العوامل غير الاقتصادية إذ أن الفاعلين الغالبين، في نظره، بإمكانهم فرض منتجاتهم الثقافية (مثلا ذوقهم الفني) أو الرمزية (مثلا طريقة جلوسهم أو ضحكهم وما إلى ذلك). فللعنف الرمزي (أي قدرة الغالبين على الحجب عن تعسف هذه المنتجات الرمزية وبالتالي على إظهارها على أنها شرعية) دور أساسي في فكر بيار بورديو. معنى ذلك أن كل سكان أي مدينة مغربية مثلا بما فيهم الفلاحون سيعتبرون لهجة فاس مهذبة أنيقة واللهجات الريفية غليظة جدًّا رغم أن اللهجة الفاسية ليست لها قيمة أعلى بحد ذاتها. وإنما هي لغة الغالبين من المثقفين والساسة عبر العصور وأصبح كل الناس يسلّمون بأنها أفضل وبأن لغة البادية رديئة. فهذه العملية التي تؤدي بالمغلوب إلى أن يحتقر لغته ونفسه وأن يتوق إلى امتلاك لغة الغالبين (أو غيرها من منتجاتهم الثقافية والرمزية) هي مظهر من مظاهر العنف الرمزي.
العنف الرمزي للمؤسسة التعليمية
إن العنف الرمزي قضية محورية في أعمال بورديو. ففي معرض تعريفه بالدولة، يعطي العنف الرمزي معنى الضغط أو القسر أو التأثير الذي تمارسه الدولة على الأفراد والجماعات بالتواطؤ معهم. ويبرز هذا المعنى على نحو جليٍّ في التعليم الذي يمارسه النظام المدرسي لناحية الاعتقاد ببديهيات النظام السياسي، أو لناحية إدخال علاقة السلطة إلى النفوس كعلاقة طبيعية من وجهة نظر المهيمنين.
وقف بورديو على الدوام ضد النظام التعليمي القائم على تلقين المعلومات ونقد بشدة المدارس ومناهجها. وحسب رأيه يجب أن تكتفي الدولة بتعليم التعليم وتدريب الناس على تحصيل المعرفة. فالرجل يرفض الأدلجة ولا يقبل أية شبهة للتأثير السياسي في التعليم.
فالمدرسة في مجتمعنا هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني الأساسية التي تنتظم في نسق كلي للمجتمع وفق قواعد محددة، وتخصصت تاريخيا في مجال الممارسة التربوية الثقافية، وتلتقي بذلك في وظيفتها وتتكامل مع الأسرة في مجال التنشئة الاجتماعية الثقافية، وقد نشأت المدرسة في المجتمع البشري الذي عرف تقسيم العمل وتشكل الدولة لتكون رديفا للأسرة في الوقت الذي استحال فيه على الأسرة تلقين النشء مختلف المعارف الثقافية، وهي تؤدي دورها هذا المنوط بها تحت هيمنة الدولة، والطبقة السائدة. فهي إحدى أجهزة الدولة الإيديولوجية في مجال الفعل التربوي، يقول ماركس: إن الأفكار السائدة هي أفكار الطبقة السائدة وهي أيضا أفكار الهيمنة .والسمة السائدة والطاغية على مؤسساتنا التعليمية هي سمة السلطوية التي
ورثها نظامنا التعليمي عن النظام التعليمي التقليدي وطعمها الاستعمار لخدمته ثم حافظت البورجوازية على إستمراريتها بعد الاستقلال. وقد بقي النظام التعليمي ممزقا وتابعا للمركز الاستعماري على المستوى التنظيمي وعلى مستوى التسيير زد على ذلك محتوى البرامج والمناهج المدرسية. كما أن الطبقة المسيطرة تهيمن بشكل مفرط على مراقبة الانتقاء لتكريس طابع التراتبية .
وهكذا فالمدرسة اليوم تلعب دورا أساسيا في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع محققة هيمنة الدولة وسيادتها بواسطة الإقناع والتراضي حسب تعبير غرامشي أو بواسطة عنف وإكراه وقسر يختلف عن عنف الدولة المادي بكونه عنفا رمزيا حسب بيير بورديو.
ويعرف لينين المدرسة بكونها أداة هيمنة طبقية في يد البورجوازية، إن هاته الطبقة المهيمنة كما يرى بورديو وباسرون، لا ترى أو أنها لا تريد أن ترى العلاقة بين التفاوتات الاجتماعية والتفاوتات المدرسية، إنهم يفسرون- الطبقة السائدة- النجاح المدرسي بكونه تفاوتا بالملكات، وبرأيهم مشكل الملكات الفكرية يطرح فقط لدى الغير المتفوقين والراسبين من أبناء الطبقات المقهورة والنجاح المدرسي في رأي البورجوازية المسيطرة يرجع إلى ميزان شخصية خاصة منذ الولادة، والمدرسة لا تخلو من انعكاس التناقضات الدولة/ المجتمع على بيئتها وأدائها الوظيفي، فكل الصراعات القائمة بين القوى الاجتماعية بسبب مواقعها المتفاوتة في بنية الإنتاج المادي والثقافي للمجتمع، تخترق المجال المدرسي وتؤثر في مضامين القرارات والمناهج وطرق التلقين، وهذا دليل قاطع على الارتباط الكبير بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي… بالدولة وبالمجتمع المدني.
إن كل خلل وظيفي يطرأ داخل المجتمع لأي سبب كان يؤثر سلبا ويخلق أزمة داخل المدرسة يكون لها تأثير على إعادة إنتاج الدولة لذاتها، وكذا إعادة إنتاج النظام الاجتماعي في مجمله. وعندما يخترق هذا الخلل الزوج السائد الأسرة/ المدرسة داخل النظام الدولتي حتى يتعرض الوجود الاجتماعي كله لخطر التفكك والانهيار.
إن المدرسة اليوم في المجتمع لا تعيد إنتاج المجتمع المبني على تساوي الحظوظ، إنها لا تزال تتخبط في إرث الإيديولوجية القديم. إرث البورجوازية المسيطرة.
إن تأثير المدرسة من حيث: نمط الحياة، التربية الأسرية والحظ في التربية كلهم مختلفين، فثقافة الطبقات المحظوظة تتساوق مع ثقافة المدرسة، وعاداتهم تماثل العادات
المكتسبة داخل المدرسة. فالمدرسة نظام خاص من أنظمة التفاعل الاجتماعي جعلها أكثر أهمية. وهي تتميز عن محيطها بالروح التي تسود داخلها وهي الشعور بالنحن، وبذلك فهي لا تعمل على صنع المستقبل دون اعتبار للحاضر. وإنما يجب أن ترتكز
على حاضر التلميذ من جميع الجوانب، وفي تركيزها على الحاضر إنما تعد وبشكل جيد للمستقبل في الوقت ذاته كما يرى جون ديوي.
إلا أن ثقافة المدرسة كما يرى باسرون و بورديو، ليست على نحو مباشر هي الثقافة البورجوازية. لكنها متساوقة معها بكيفية مباشرة، خصوصا عبر السلوكات الذهنية، واللسانية والثقافة، وتم تصور أشغال المدرسة وخصوصا اشتغال العلاقة البيداغوجية كآلة لإنتاج التفاوتات الاجتماعية، إذ لا يمكن الحديث عن فرصة تساوي الحظوظ ليس لآن المواهب التي تتحدث عنها الطبقات المهيمنة موزعة بكيفية متفاوتة بل لأن المدرسة تشجع التدابير الخاصة بالطبقات المبجلة، إن جل ميكانيزمات المدرسة هي في الأصل أساليب لانتقاء أطفال الطبقة المحظوظة وإقصاء الآخرين. فمدرسة إعادة الإنتاج حسب بورديو لا تنتج أطفالا أحرارا، خصوصا وأن التفاوتات المدرسية منظور إليها كتفاوتات في الاستحقاق. تضفي الشرعية على التفاوتات الاجتماعية التي تصدر عنها وتعيد إنتاجها.
إن المدرسة أداة للخضوع والامتثال، وسواء باسرون و بورديو أو آخرون يربطون وظيفة المدرسة ببنية الطبقات الاجتماعية. أما اليتش فحين ينتقد المدرسة فلأنه يرى أنها تنتج التفاوتات الطبقية.
فهي تلعب بذلك دور المحدد الأساسي في التقسيم الطبقي، ويضيف اليتش أن المدرسة مكان لم يلجه نصف البشر وتبقى بذلك المدرسة لا تهدف إلا لتطوير صناعات عقول مملوءة وهو نوع آخر من التبضيع الدراسي والثقافي. إن تنظيم وظيفة النظام التعليمي تترجم باستمرار وبواسطة شفرات متعددة التفاوتات الطبقية على المستوى الاجتماعي إلى تفاوتات على المستوى المدرسي.
فالمدرسة مثلا تحت ظل ديمقراطية التعليم والمساواة- و هذا شعار طالما رفعته دول عديدة- تحدد الناجح وغير الناجح، والمتقدم والمتأخر، ولكن ولأن الرأسمال الرمزي متفاوت بفعل تفاوت المستويات المجتمعية – فمجموع معارف الأغنياء يتناسب مع سواهم لأن المدرسة تحاكم الجميع وفقا لـ “رأسمال رمزي” لمجموعة واحدة هي عادة الطبقة الوسطى. فتصير هذه المؤسسات أداة طبقية لـ “إعادة إنتاج” السلطة القائمة في المجتمع. طالما أن معايير التمايز هي وفقا لطرف واحد وليس معيار كلي.
ومن أجل أن يتم اعتماد قيم الطبقة الوسطى كمعايير تربوية، يمارس “ العنف الرمزي باعتبار أن أي آلية تربوية ستمارس جهدها لإبراز قيم وإخفاء أخرى. فالخطاب التربوي ليخفي الهيمنة، يلجأ لمفاهيم النظام والعقاب، ويمارس على نطاق واسع ومستويات مختلفة،وبالتالي فـ “ العنف الرمزي ” هو لصيق العملية التربوية
دائما مهما كانت. وتصير المسارح والسينما والفنون الجميلة والهوايات التي تتمكن منها هذه الطبقات قيم سامية، فيما ربما لا يعد الصيد مثلا كذلك .. وحتى هواية التصوير الفوتوغرافي بعد التقدم التقني الذي يجعل معداته بوسع الجميع تقريبا، يخرج من كونه علامة ثقافية معتبرة.
إن النظام التربوي في المجتمعات ذات التفاوت الطبقي كما يرى بورديو يعتبر أحد الآليات الأساسية الفعالة في ترسيخ النمط الاجتماعي السائد في تلك المجتمعات،وهذا يبدو جليا من خلال بنية الفرصة النسبية المتاحة لأبناء الطبقات المختلفة لدخول النظام التعليمي في مراحله المختلفة،هذا من جهة ومن جهة أخرى ثمة مظهر آخر لهذا العنف الممارس القوى السائدة وهو في تنوع المدارس في المجتمع الواحد واختلاف مستوياتها باختلاف أصول الطبقية للتلاميذ الداخلين إليها،فأبناء الطبقات العليا هم الذين يحتلون المدارس ذات النوعية الرفيعة،وعلى ذلك فالتنوع في المدارس واختلاف مستوياتها إنما يعكس صور هذا التفاوت الطبقي ويجسد بشكل واضح أحد أهم مظاهر العنف الثقافي في المجتمعات الحديثة.
فعند دراستنا للحقل المدرسي نلاحظ أن فيها تعسفا رمزيا تشرعه القوانين والتقاليد المدرسية التي تشتمل في مكوناتها الظاهرة على عدالة مصدرها تكافؤ الفرص وخضوع الجميع للقانون. وعليه فالسلطة المدرسية تتسلم في واقع الأمر تفويضا من الطبقات المهيمنة لفرض التعسف الثقافي، فعن طريق هذا التفويض يتم تمرير العنف الرمزي بلطف.
فلو أخذنا مثالا كاللغة سنجد أن التلميذ الغني يختزن في ذاكرته رصيدا لغويا هائلا بالمقارنة مع التلميذ الفقير. فالأول يستعمل لغة تجريدية وله بروتوكول وإتيكيت عالي المستوى وله اهتمامات ثقافية ومدى اجتماعي واسع من العلاقات ورصيد من السلوكات والخبرات لم تكن متاحة لزميله الفقير، وحين يتقدم الاثنان إلى الامتحانات من الطبيعي أن تكون فرصة الطالب الغني في النجاح وتحصيل القدر الأكبر من العلامات أكثر من فرصة الطالب الفقير. هذا الواقع ينطوي على تعسف ثقافي مشروع يعترف به الجميع دون أن يدركوا ظلمه وفداحته، فليس من العدل أن يخضع التلميذان لامتحان من نفس النوع والمستوى في حين يتمايزان بشدة فيما لديهما من رصيد وفرص للنجاح.
العنف الرمزي للتلفزة
يتبع
بالتوفيق للجميع
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا

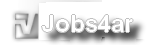




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

