قرينة البراءة في قانون المغربي
تمهيـــــــد
يحتل موضوع البراءة أهمية قصوى كما يشكل احد المواضيع المحورية التي تدور حولها اغلب الملفات التي تعرض على المحاكم في المجال الجنحي و الجنائي، ذلك أن هذا الموضوع يشغل اهتمام جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان و في مجال العدالة.
لذا فان سبر أغوار هذا المبدأ تدفعنا أولا إلى البحث في تأصيله زمانيا و تشريعيا على المستوى الدولي و الوطني، هذا مع البحث في قرينة البراءة و هي تصطدم بالواقع العملي للمكلفين بصونه و حمايته.
أولا - تأصــــيل المبدأ :
نشأت فكرة الأمن منذ ان خلق الإنسان الذي وجد نفسه مهددا من طرف الكوارث الطبيعية و الحيوانات المفترسة ليجد نفسه أخيرا مهددا من طرف بني جنسه لذا فقد عمل الإنسان على حماية نفسه من كل الأخطار بعدة وسائل أهمها العيش داخل تجمعات تهيئ له وسائل الأمن الضرورية، كالأسرة و العشيرة و القبيلة ثم الدولة، و في نفس الوقت اهتم المسؤولون عن هذه التنظيمات بأمن رعاياهم و اختلفت أنظمة الأمن باختلاف البلدان و الأمصار و اختلاف العصور، و قد شهد التاريخ البشري عدة تطورات متعاقبة كانت في عمقها تنسج لفائدة رد الاعتبار لإنسانية الإنسان باعتباره محور الكون و باعتباره أيضا المنطلق و الهدف.
لذا فان الحديث عن العدالة الجنائية هو حديث ذو شجون بل هو حديث كل العصور إذ ظلت الإنسانية منذ وجدت تنشد العدالة الجنائية و تسعى نحو تحقيقها، و قد افرز هذا السعي تراثا ضخما غنيا و ممتدا في الزمان و المكان بمدارسه الفكرية و نظرياته الفقهية و علومه الجنائية و تشريعاته التطبيقية، و في نفس السياق سارت كافة الشرائع السماوية سعيا مهما نحو تحقيق عدالة إنسانية.
وقد اتجهت الشريعة الإسلامية نحو تكريم الإنسان ككائن اجتماعي و ذلك حفاظا أيضا على كل القيم الاجتماعية التي يومن بها و التي قد تضمن الاستقرار المجتمعي، فعن رسول الله { ص } انه قال " كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه".
و قال أيضا " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا عن سبيله فلئن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة".
و عن عمر بن الخطاب رضي الله عن قال " لئن أعطل حد بالشبهات أحب إلي من أن أقيم حدا بالشبهـات ".
و على نفس النهج سار فلاسفة الأنوار الذين اصلوا لفكر إنساني تقدمي يحفظ للإنسان أدميته إذ أنهم دافعوا و باستماتة على اعتبار البراءة هي الاصل في الإنسان إلى أن تثبث إدانته بناء على محاكمة عادلة.
و لعل أن هذا الفكر الذي سطع نجمه في فرنسا سيكتسح باقي القارة الأوروبية التي ستؤسس لميلاد موجات الدساتير المكتوبة.
إلا أن الأحداث الدامية و الماسي الإنسانية التي شهدها العالم خلال القرن التاسع عشر و القرن العشرين، ستتوج مع انتهاء الحرب العالمية الثانية بصدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10/12/1948 و الذي صادقت عليه الأمم المتحدة عقب صدوره، و الذي نص على مجموعة مبادىء تتجه أكثر نحو بناء عدالة جنائية و اهتمام متزايد بالإنسان و بحقوقه باعتباره محور الكون، و تضمن للإنسان براءته إذ نص الإعلان في مادته 11 على أن " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه ".
كما نصت المادة 5 من مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.
و المغرب باعتباره عضوا نشيطا في المجتمع الدولي و يسعى نحو بناء صرح مجتمع تصان فيه حرية الأفراد في تناغم مع استقرار المجتمع، فانه نص في ديباجة دستور الدولة على أن المملكة المغربية تتعهد " بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية" من مبادىء و حقوق و واجبات و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف دوليا.
و بالإضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة في نص الدستور المغربي فان قانون المسطرة الجنائية قد أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها و تقويتها، إذ نص في الفصل 288 ق.م.م القديم على انه على القاضي أن يقرر عدم إذانة الشخص المتهم و يحكم ببراءته كلما رأى أن الإثبات غير قائم، إلا انه ومع التطورات الأخيرة التي عرفتها البلاد سيقع التنصيص صراحة ولأول مرة بقانون المسطرة الجنائية على اصل البراءة في الإنسان.
و مادام أن الحفاظ على براءة الإنسان و صيانتها من كل تسلط قد يطالها، يعد هدفا أسمى فان المشرع المغربي قد كفل لذلك نصوصا تشريعية في قوانين تدخل في تقاطع مع هذا المبدأ كقانون الحريات العامة.
صحيح أن الفكر الجنائي قد تطور و ارتقى و كافحت الشعوب و المجتمعات و أدت الثمن غاليا حتى أصبح للعدالة الجنائية مبادىء خالدة يعز على الإنسان أن يفرط فيها أو يتنازل عنها ، و لكن في نفس الوقت كشفت التجارب في هذا الميدان أشكالا جديدة من التحديات و التطورات المتلاحقة و أصبح معه البحث عن الحلول يفرض نفسه على نحو مستقر في أفق تفعيل العدالة الجنائية على جميع المستويات بعيدا عن كل تقصير أو ارتجال.
إذ أننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية عملية مهولة تكتسح كل أصناف العلوم بما فيها العلوم القانونية و لا شك أيضا أن المجتمعات الإنسانية تعيش تقلبات كبرى و تغييرات ملحوظة في قيمها و أعرافها، جعلت العلاقات الاجتماعية أكثر تعقيدا، لذا كان من الطبيعي أن ينظر إلى العدالة الجنائية انطلاقا من هذا الواقع المتحرك في إطار فلسفة واضحة المعالم محدد الأهداف.
و في هذا السياق كان التعديل الذي د شنه المشرع بإصدار قانون المسطرة الجنائية الجديد، إلى جانب فتح أوراش قانونية جديدة الهدف منها هو محاولة إرساء قواعد عدالة جنائية متطابقة مع واقع شعب ينشد التقدم و الاستقرار.
أفإلى أي حد استطاع المشرع المغربي صيانة مبدأ البراءة كما كرسته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؟
أو هل يعكس الواقع العملي للمكلفين بصون المبدا طموح المشرع ؟
أو ما هي الوسائل الكفيلة للحفاظ على هذا المكسب ؟
تدور فلسفة المحاكمة العادلة حول وعي معرفي مؤسس لها وعي معرفي عميق بان تحقيق العدل، معادلة معقدة بقدر تعقد العوامل التي تولد السلوك الإنساني، وبقدر تشعب المعايير التي تقيد هذا السلوك وتوجهه، ووعي بان العدل مخلوق آدمي لا يرقى إلى مصاف العدل المطلق، الشيء الذي يحتم الحرص على تحصينه من ضعف الإنسان ومن طغيانه، وكما تدور فلسفة المحاكمة العادلة على فكرة التوازن، التوازن في نشدان الحق بين السائل والمسؤول، بين التابع و المتبوع، بين الجاني والمجني عليه، بين المنحرف والمجتمع الذي افرز الانحراف، وبين أهداف الجزاء الجنائي من وقاية وزجر وردع وإصلاح.
ثانيا - التشـريع المغربي و قرينة البراءة و مــدى ملائمته مع المواثيق الدولية لحقـوق الإنسـان
نص تصدير دستور المملكة المغربية المصادق عليه على اثر استفتاء 13 شتنبر 1996 على أن المحكمة المغربية تتعهد " بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادىء و حقوق و واجبات و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".
و الواقع أن الدساتير المغربية السابقة انطلاقا من دستور 1962 و مرورا بدستور 1970 إلى غاية دستور 1973 كانت قد أدرجت ديباجتها تعهد المملكة المغربية" بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنضمات الدولية من حقوق و واجبات " و لكن الجديد في دستور 1992 و الذي تم ترسيخه أكثر في الدستور الحالي هو النص على تشبت المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، و يعطيها تعريفا معينا هو ذلك المتعارف عليه عالميا.
لذا كان لزاما على الدولة المغربية أن تسعى إلى ملائمة تشريعاتها الداخلية مع المواثيق الدولية و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تماشيا مع روح نص الدستور.
و يعد قانون المسطرة الجنائية من أهم القوانين اللصيقة بحقوق الإنسان نظرا لارتباطها بالحريات الفردية و الجماعية، و لذلك كان من الضروري أن ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أمرا مفروضا و بكل إلحاح.
إن قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا يضبط إجراءات المحاكمة العادلة الجنائية، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يستوعب كل الحقوق التي قررتها المواثيق الدولية بحقوق الإنسان، لان تلك الحقوق مختلفة و متنوعة و بعضها بعيد كل البعد عن اهتمام قانون الإجراءات الجنائية.
أما بخصوص قرينة البراءة فتماشيا مع ما هو منصوص عليه في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و في المادة 14 الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و اللتان تقرران بأن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى حين ثبوت ادانته قانونا في إطار محاكمة عادلة، صار المشرع المغربي على إثر التعديلات الأخيرة المدخلة على المنظومة الجنائية المغربية، وذلك صونا منه لهذا المبدأ وتأكيدا أيضا لإيمانه الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
ولعل أن أهمية هذا المبدأ تتجلى في أنه يختزل كل الحقوق المقررة للمتهم فهو لا يعتبر بريئا إلى حين أن تتم ادانته في إطار محاكمة عادلة من طرف محكمة تتمتع بالاستقلال و مكونة وفقا للقانون.
لذا فقد وقع التنصيص على هذا المبدأ في الفصل 82 من دستور المملكة، و هو بذلك قد وضع في أعلى مرتبة تسمو به عن كل مناقشة مبدئية من حيث وجوب إدراجه بالقوانين الأخرى، و منها قانون المسطرة الجنائية الذي دعم استقلال القضاء في إصدار الأحكام و نص على أن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم م (286 ق م ج).
لذا فإن قرينة البراءة قد تصدرت قانون المسطرة الجنائية في مادته الأولى و وردت بصياغة متشابهة لمقتضيات المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نصت المادة الأولى من ق.م.ج. بأن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إذانته قانونا بمقتضى محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية.
و بذلك قررت المادة الأولى من ق. م.ج. تبني كل شروط المحاكمة العادلة التي تقررها المواثيق الدولية في نفس الوقت فان هذا القانون قد أحاط قرينة البراءة بعدة تدابير عملية لتعزيزها و تقويتها سنتولى فيما يلي الإشارة إلى بعض مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03-03 في إطار تدعيم قرينة البراءة و صيانتها من كل ما قد يطالها من خروقات :
-اعتبار الاعتقال الاحتياطي و المراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين.
- تحسين ظروف الحراسة النظرية و الاعتقال الاحتياطي وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية.
-ترسيخ حق المتهم باشعاره بالتهمة المنسوبة إليه.
- ضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو الاستعانة بشخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، مع إمضاء المترجم على المحضر { المادة 21} و هذه الضمانة يكفلها القانون للشخص أمام النيابة العامة و أمام قاضي التحقيق و الحكم.
-النص على إشراف وزير العدل على السياسة الجنائية و تبليغها للوكلاء العامين للسهر على تطبيقها { م 51}.
-حق الشخص المتهم في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية.
-حق المتهم في الاتصال بمحاميه خلال فترة تمديد الحراسة النظرية وحق المحامي في تقديم ملاحظات كتابية خلال تلك الفترة.
-منع تصوير الشخص المعتقل الذي يحمل أصفادا أو قيودا أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه و المعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كان بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهما أو ضحية دون موافقته.
-تعريف المحضر الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية و تحديد الشكليات المتطلبة في إنجازه توخيا للدقة و الضبط و سلامة الإجراءات.
- إحداث مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحاكم الابتدائية بالإضافة إلى استمرار المؤسسة الموجودة لدى محاكم الاستئناف.
- كما أحدث المشرع في نفس القانون تدبير الوضع تحت المراقبة القضائية كبديل للاعتقال الاحتياطي، والذي لم ينص عليه المشرع في قانون 1959، وهو تدبير ذو بعد إنساني مما يوفر لقاضي التحقيق إمكانية بديلة مهمة وفعالة من شأنها ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق الجنائي في إطار محاكمة عادلة وضمان لحقوق الدفاع، وقد توخى المشرع من خلال هذا التدبير إيجاد آليات تكفل حسن سير تطبيق الإجراءات القضائية دون اللجوء إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي.
- كما نص الفصل 457 من نفس القانون على إمكانية الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف من قبل أطراف الدعوى، ولتوفير المزيد من الضمانات فإن غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن تتكون من رئيس وأربعة مستشارين لم يسبق لهم النظر في القضية.
- حماية الأحداث الجانحين وتقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، وقد سلك القانون الجديد في معالجته لقضايا الأحداث اعتمادا على مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كانت إذن أهم الضمانات التي نص عليها المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية الجديد والتي يهدف من وراءها ضمان شروط محاكمة عادلة وتقرير لقرينة البراءة كأصل في المتهم إلى حين إثبات إدانته.
أفإلى أي حد تعتبر هذه المستجدات منسجمة وروح النص العالمي لحقوق الإنسان ؟
1 - حول الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية :
اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين، وحيث أن هذه النظرة الجديدة بخصوص هذا التدبير قد استلهمت من روح الميثاق العالمي لحقوق الإنسان... وكذلك من المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في الفقرة رقم 2 إذ نصت على إبلاغ كل شخص عند القبض عليه، بلغة يفهمها بأسباب القبض عليه وإبلاغه على وجه السرعة بأي تهمة تنسب إليه مع عرض المقبوض عليهم او المحتجزين على قاضي أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية ومن حقهم أن يقدموا إلى المحكمة في غضون مدة زمنية معقولة أو يفرج عنهم، مع افتراض براءة المتهم بارتكاب فعل جنائي إلى أن تثبت إدانته محكمة مختصة ...
كما عمل المشرع المغربي على تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وإحاطتهما بإجراءات صارمة من طرف السلطة القضائية كما هو منصوص عليه في الفصل 165 ق.م.ج. إلى الفصل 188 من نفس القانون مع ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة المنسوبة إليه فقد نص�ال�ند ج من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن تتم محاكمة المتهم دون تأخير زائد عن المعقول.
وقد سار قانون المسطرة الجنائية في هذا الاتجاه فحدد آجال الحراسة النظرية في مدة 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة 24 ساعة فقط (أو 96 ساعة قابلة للتمديد لمدة مساوية في جرائم أمن الدولة.
مع التزام النيابة العامة بعرض المتهم المعتقل بناءا على مسطرة التلبس فورا على الجلسة وعلى الأكثر خلال 3 أيام في الجنح أو 15 يوما في الجنايات (المادتان 73-74 ق.م.ج.).
وفيما يخص آجال الاعتقال الاحتياطي لا يمكن بمرورها استمرار اعتقال الشخص الخاضع للتحقيق ويتعين الإفراج عنه بقوة القانون كحد أقصى ثلاثة أشهر في الجنح وسنة واحدة في الجنايات وحق المتهم في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية.
2- حق المتهم في الاستعانة بمترجـم :
نص المشرع المغربي على هذا الحق في مختلف مراحل المسطرة انطلاقا من مرحلة الشرطة القضائية (م21)، وكذا أمام النيابة العامة (المواد 47 و 73 و 74ق.م.ج.)، وفي مرحلة التحقيق (م 111 ق.م.ج.) وفي مرحلة المحاكمة (المواد 304-318-423-435 ق.م.ج.).
وأكد المشرع على ضرورة الاستعانة بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو الاستعانة بشخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر وكذا إذا كان أصما أو أبكما.
وذلك انسجاما مع الفقرة 9 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على أنه من حق المتهم التوفر على مساعدة مجانية للمترجم إذا كان غير قادر على فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث بها.
3- حق الاستعانة بالمحامي أثناء فترة الحراسة النظرية :
ذلك أن الجديد في هذا الإطار هو حق المحامي في الحضور إلى جانب موكله المتهم الذي هو تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها (المادة 66 ق.م.ج.) ويتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة، ابتداءا من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة، قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية.
وقد نصت المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعب في الفقرة (ه) البند الأول على ضرورة توفر المتهمين على الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم، وان يتصلوا في إطار من السرية بمحاميهم الذين يختارونهم.
هذا بالإضافة إلى أن المشرع المغربي قد أحاط قرينة البراءة بمجموعة من الضمانات الأخرى والتي تهدف في مضمونها إلى ضمان شروط محاكمة عادلة من جملة منع تصوير الشخص المعتقل الذي يحمل أصفادا أو قيودا أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهما أو ضحية دون موافقته، مع التأكيد كذلك على أن الشك يفسر دائما لصالح المتهم.
كما ان المشرع بادر إلى منع الاعتقال التعسفي إذ نص في المادة 148 ق.م.ج. على التنصيص على أن كل قاض أو موظف يأمر بإلقاء متهم في السجن أو يسمح بإبقائه فيه عن قصد، يتعرض للعقوبات المقررة للاعتقال التعسفي وهذه العقوبات منصوص عليها في الفصل 225 إلى 231 ق.ج وذلك انسجاما مع ما تقضي به المادتان 9 من الإعلان العالي لحقوق الإنسان و المادة 9 فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللتان قد حظرتا كل اعتقال تعسفي.
4- حماية الأحداث الجانحين :
كما خصص المشرع المغربي ضمانات هامة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة الأحداث، وذلك وفق ما هو متعارف عليه عالميا في ميدان حقوق الطفل، وخاصة إعلان حقوق الطفل لسنة 1959 بالإضافة إلى قواعد بكين المسماة بقواعد الأمم المتحدة "الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث" ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث المسماة بمبادئ الرياض لسنة 1990.
وكذلك اتفاقية الطفل بتاريخ 20/11/1989 المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير رقم 363/93/1 بتاريخ 21/11/1996.
ولعل ان المشرع المغربي قد أبان من خلال التعديلات الأخيرة التي دشنها عن نية صادقة نحو الدفاع عن قيم حقوق الإنسان إلا أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان تتطلب إعمال بنودها والتقيد بمقتضياتها، وإلا فلا فائدة من المصادقة عليها، وأول ما يقتضيه ذلك هو إقرار سمو الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب على القانون الداخلي، مع ما يترتب على ذلك من ملائمة القوانين الداخلية مع هذه الاتفاقيات.
هذا المبدأ البديهي ظل طيلة العقود الماضية محل نقاش كانت الغلبة فيه قضائيا للرأي القائل بعدم إعطاء الاعتبار لبنود الاتفاقيات الدولية وبعدم إعمالها قضائيا ورفض فكرة سموها على القوانين الداخلية، رغم وجود شبه إجماع لفقهاء القانون وحقوق الإنسان وللمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا، على إلزامية سمو الاتفاقيات الدولية بمجرد المصادقة عليها وضرورة الخضوع لبنودها، رغم أن المغرب ملزم بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة لبيان مدى احترامه لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأكبر ما يؤخذ عليه في هذا المجال هو عدم ملائمة القوانين الداخلية لبنود العهد الدولي وعدم نص الدستور على بعض الحقوق الأساسية التي أقرها.
ولعل أن التقرير الأخير الذي تقدم أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والذي تلا أحداث 16 ماي الإرهابية والتي سجلت مساسا وخرقا خطيرين لحقوق الإنسان ولضمان شروط محاكمة عادلة، وكذا تدخل سافر في المس باستقلالية القضاء، قد أعاد التساؤل إلى أذهان المهتمين بخصوص التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
إلا أنه إذا كانت إرادة المشرع قد ذهبت إلى وضع قانون وطني ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، فإن الاختلافات التطبيقية الجزئية التي تعتري صياغة النصوص أو فهمها أو حتى تطبيقها، لا تأثير لها على جوهر تلك الحقوق لأنها تبقى خاصة بكل دولة بالنظر لإمكانياتها المادية والفكرية وثقافتها وتقاليدها ونظامها القانوني، ذلك أن المهم ليس هو توحيد تطبيق النصوص في مختلف أنحاء العالم، وإنما إيجاد حد أدنى لممارسة الحق بشكل مقبول في أغلب دول العالم.
ثالثا - قرينة البراءة : الواقع العملي أية ضمانات ؟
يتفق فقه القانون الجنائي على أن أهمية القانون الجنائي تجعله يحقق أهدافا ثلاثة هي الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة والدفاع عن المصالح المشتركة، وبغض النظر عن الآراء المختلفة للفقه في مجال تقدير هذه الأهداف وجعل أحدها أقوى من الآخر لدرجة أن بعض الفقه يذهب إلى القول بأن الاستقرار القانوني هو الهدف الوحيد للقانون الجنائي، وأن العدالة والمصالح المشتركة ما هما إلا عنصران لهذا الاستقرار.
فلتحقيق الاستقرار القانوني لا بد من تقنين القواعد العقابية أو الجنائية حتى يعلم الأفراد ما هو محظور وما هو مباح فمن حق كل فرد أن يشعر باطمئنان ليباشر نشاطه ويعيش حياة هادئة بعيدة عن المخاطر والاضطرابات، ولهذا يتعين لتحقيق الاستقرار القانوني تقرير القاعدة العالمية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وما ينتج عنها من قواعد مهمة تضمن شروط محاكمة عادلة وتضمن للإنسان براءته.
لذا فإن البحث في واقع قرينة البراءة تضطرنا للبحث في جميع المراحل التي تمر منها الدعوى حتى تصبح جاهزة للنطق بالحكم فيها، وذلك للوقوف عند واقع قرينة البراءة وهي تصطدم مع عمل المكلفين بصونها وتقريرها وذلك عبر المراحل التي يمر منها الظنين أو المتهم حتى ينطق بالحكم في حقه إما بالإذانة أو البراءة.
1- الضابطة القضائية و قرينة البراءة :
لقد أسند المشرع المغربي للضابطة القضائية مهمة التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، وذلك في إطار تنفيذ إنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، مما يجعل هذه المرحلة الأكثر اصطداما مع قرينة البراءة، فخلال هذه المرحلة فإن الضباط يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون البحث التمهيدي تحت مجموعة من الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والتي سبقت الإشارة إليها.
والظنين في هذه الحالة هو الشخص الذي يشك فيه على أنه ارتكب الفعل الجرمي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسميته بالمتهم أو الفاعل أو المجرم رغم وجود أدلة قاطعة ضده، من شأنها تبرير إدانته، ذلك أن مثل هذه التسميات خاصة بمراحل أخرى من مراحل التحقيق.
ويعتبر الظنين الشاهد الثاني في القضية بعد الضحية فهو يكون حاضرا أثناء ارتكاب الفعل، ولهذا فشهادته لها أهمية بالغة، مما يحتم على ضابط الشرطة القضائية الاستماع إليه بكل دقة وحذر، فهو يستمع إليه بالطريقة التي يستمع فيها إلى الشهود.
إلا أن الواقع العملي خلال هذه الفترة من البحث تؤكد على أن الضابطة القضائية تتجاوز حدود اختصاصها في مجموعة من الحالات خاصة خلال فترة الهزات التي تعرف خروقات سافرة من اعتقال المتهم دون وجه حق واقتياده إلى مراكز الدرك أو الأمن مع نزع اعترافاته بالقوة والعنف في أبشع الصور، مما يؤثر على حسن سير العدالة، وذلك عملا بمنطق راسخ لدى ضابط الشرطة القضائية أن كل من قدمت في مواجهته شكاية فهو متهم وعليه أن يثبت براءته أمام القضاء وليس أمامها.
ولعل أن اللجوء إلى معاقبة المشتبه فيه قبل أن يصدر أي حكم في حقه تذكرنا صراحة بأساليب امتحان براءة أو إدانة المتهم وذلك برميه في واد سحيق أو داخل نار ملتهبة فإن احترق بالنار المقدسة فهو بريء وإن لم يحترق فهو مذنب ويستحق العقاب وهو ما يسمى في التاريخ البشري بالطريقة الكردالية في العقاب، والأساس عندها أن كل مشتبه فيه يعاقب وعليه أو بالأحرى فعلى الطبيعة أن تثبت براءته.
ورغم دقة هذه المرحلة فان ضباط الشرطة القضائية -وحسب شهادات نابعة من عمق الواقع، إما من طرف أظناء أو ضباط متقاعدين- فإنها تشهد على ان العقلية السائدة هي دائما التطاول على سلطة القانون وإعمال سلطة الأهواء، وفي بعض الأحيان سلطة التعليمات.
إذ أن الظنين يمر من مرحلة استنطاق غير قانونية ليقدم محضره أمام النيابة العامة والذي قد يكون في غالبية الأحيان مفتقر لبيانات شكلية وأخرى موضوعية بحكم أنه أنجز في غيبة أية مراقبة صارمة لعمل ضابط الشرطة القضائية.
أمام هذه المعطيات فإن الظنين الذي أضحى بريئا بنص قانوني صريح، عليه إثبات براءته فيما سيأتي من مراحل الدعوى، وما يؤكد أكثر ذلك هو أن نسبة عالية من الشكايات الموجهة ضد أظناء تحال على النيابة العامة بمحاضرها لتقرر فيها ما تراه ملائما.
فالظنين لا يتوفر على أية ضمانات في مرحلة البحث أمام الضابطة القضائية، وذلك في البلدان التي لا يسمح فيها للمحامي بمؤازرة موكله أمام الشرطة القضائية.
أضف إلى ذلك أمية الأظناء الذين قد ينكرون وعن حق تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، الأمر الذي يضعنا أمام جدل أساسي بأن يثبت الظنين أن التصريح المدون بالمحضر لم يصدر عنه أمام محاكم غالبا ما تأخذ بالتصريحات الواردة بالمحضر سيما تلك المتعلقة بالجنح والمخالفات لأنها تلقاها موظف عمومي.
ورغم ان تمديد مدة الحراسة النظرية يحتاج إلى وجود أدلة قوية تبرر ذلك، وهذا شيء منطقي، إذ لا يعقل أن يستمر توقيف شخص دون وجود أدلة قاطعة ضده، هذا وأن الشخص قد ينتظر يوما كاملا ليتم إخباره في المساء بوضعه تحت الحراسة النظرية، بالإضافة إلى عدة تجاوزات اشتكى منها الاظناء أمام المحاكم كالتوقيف أكثر من المدة القانونية وغيرها ...
فكثيرا ما تعمل مثلا الضابطة القضائية على اعتقال السائقين الذين يتعاطون لنقل الركاب بدون رخصة، ويتم تقديمهم رفقة مسطرة مباشرة إلى النيابة العامة التي تحيلهم على المحكمة في حالة اعتقال، والواقع أن هذا الإجراء غير قانوني ذلك أن المحاضر المتعلقة بقانون الجولان يجب إرسالها مباشرة إلى وزارة النقل التي تقرر إحالة الملف على المحكمة الشيء الذي يعني عدم جواز الاعتقال من أجل نقل الركاب بدون رخصة.
وفيما يتعلق بمكان الحراسة النظرية، فإنه قبل وضع الظنين في مكان ما يتعين تثبيته تثبيتا وقائيا، مع سحب كل ما من شأنه الأضرار بسلامته أو سلامة الغير، فكثيرا ما تحدث انتحارات أو اعتداءات على الأشخاص بسبب الإهمال.
غير أنه رغم ان هذه المرحلة لا زال فيها الشخص بريئا فإنه كما -أسلفنا- يعامل وكأنه مجرم وتنتهك حرمته وحرمة مسكنه أثناء تفتيش المنازل خارج نطاق القانون ودون أن يحترم حقه في الإمضاء على المحضر. تماما كما حصل خلال فترة الاعتقالات التي تلت أحداث 16/05/2003 الإرهابية... وكذا المحاكمات الشهيرة التي عرفتها البلاد أثناء الهزات خلال الفترة الممتدة من الستينات إلى نهاية الثمانينات والتي مهدت الطريق لصدور قانون الإرهاب والذي تضمن بدوره إجراءات تسير في اتجاه تشجيع الممارسات التعسفية وخرق مواد الاتفاقيات الدولية، بعدما منحت سلطات أكبر للضابطة القضائية، ذلك أن جميع المتابعات التي تمت في حق المشتبه فيهم قد سجلت عدة خروقات أهمها عدم اعتماد قرينة البراءة وأن الشك في صالح المتهم.
ناهيك عن أن مدة الحراسة النظرية المنصوص عليها قانونا قد تم تجاوزها وعمدت المصالح المعنية إلى تزوير تواريخ الاعتقال في عدة حالات لتحديد مدة الاستنطاق وذلك حسب شهادات مجموعة من رجال الدفاع وعائلات المشتبه فيهم.
وفيما يتعلق بجزاء عدم احترام إجراءات الحراسة النظرية، فقد اختلفت المحاكم بما في ذلك مع المجلس الأعلى حول هذا الجزاء، فمنها من رتبت البطلان كلما وقفت عند أي خرق للمقتضيات المتعلقة بالحراسة النظرية ومنها من اعتبرتها مقتضيات لا يترتب على خرقها أي جزاء.
ففي تاريخ 29/05/1984 أصدر المجلس الأعلى قرارا جاء فيه :
"كل إجراء أمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم يكن الفصل 765 ق.م.ج.".
إن عدم إنجاز إجراء مسطري على الوجه القانوني في محاضر الضابطة القضائية لا يؤدي إلى بطلانها من أساسها وإنما يعتبر الإجراء كأن لم ينجز ويبقى العمل بالمحاضر على سبيل البيان عملا بالفصلين 293 و 765 من ق.م.ج. ولا يقبل من المتهم ادعاءه أمام المحكمة أنه وقع تجاوز في مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة والحال أن محضر الضابطة القضائية الذي وقع عليه يفيد أن مدة الحراسة كانت قانونية".
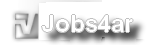


 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
