بحث حول المصادر الاحتياطية للقانون بحث بعنوان المصادر الاحتياطية للقانون
المصادر الاحتياطية للقانون *خطّة البحث :
- المقدّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـة.
* المبحث الأوّل : الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي للقانون .
• المطلب الأوّل: مـــفــــهــــوم الــــشــــريــعـــة الإسـلامـية لـغــة، و اصــطـلاحـا.
• المطلب الثاني: التفرقة بين الفقه الإسلامي، و مبادئ الشريعة الإسلامية.
• المطلب الثالث: مــصــادر الأحــكــام الــشــرعــيــة الــمــتّــفــق عـــلـــيـــهــــا.
• المطلب الرابع: مكانة مبادئ الشريعة الإسلامية من بين مصادر الـــقانون
الـجـزائـري .
*المبحث الثاني: العرف كمصدر احتياطي للقانون.
• المطلب الأوّل: مـــــفــهــوم الـــعـــرف، و أقـــســـامــه.
• المطلب الثاني: مــــــزايـــــا الـــعــــرف، و عــــيــوبــــه.
• المطلب الثالث: أركــــــــــان الــــــــعـــــــــــــــــــــــــــرف.
• المطلب الرابع: دور العرف، و أساس القوّة الملزمة له.
*المبحث الثالث: مبادئ القانون الطّبيعي، و قواعد العدالة.
• المطلب الأوّل: الـمـقــصــود بمــبادئ الــقانون الــطّـــبيعـي، و قـواعـد الــعــدالـة.
•
المطلب الثاني: المقصود بالإحالة على مبادئ القانون الطّبيعي،و قواعد
العدالة. • المطلب الثالث: مدى ملائمة الإحالة إلى مبادئ القانون
الطّبيعي، و قــواعد العدالة.
- الخـــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــ ـة.
** المقدّمة:
بسم الله عليه نستعين، و سلام على نبيّيه، و الصلاة على حبيبه الصادق الأمين أمّا بعد..
لا
شكّ أنّه حدث أن تساءلنا عمّا يلجأ إليه القاضي في حــال لم يجد نصّا،أو
حلاّ في التـّشريع المعروض عليه؛و من هذا المنطلق أتى بحثنا هذا مجيبا عن
هذا التساؤل لأهميته القصوى.
فكلنّا يعلم أنّ التشريع هو أولّ ما يلجأ إليه القاضي باعتباره المصدر الرّسمي الأوّل،و لـــكنّ
التشريع
كثيرا ما يكون قاصرا، و هذا ما يستدعي لجوء القاضي في هذه الحال إلى مصادر
أخرى فرعية تدعى: المصادر الاحتياطية للقانون، و يكون مجبرا على تطبيقها،
و إلاّ يُعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة.و هذه المصادر سنتناولها من
الأهمّ إلى المهمّ بدءًا بمبــادئ الـشريعة الإسلامية، كمصدر رسميّ
احتياطيّ بعد التّشريع- و هذا نظرًا لشمولــية الدّين الإسلامي،و ما
يتضّمنّه من أحكام عامّة، و شاملة؛ فالشريعة الإسلامية حسب اتفّاق العلماء
هي مصـدر كلّ تشريع، أو تنظيم في المجتمع الإسلامي- لِيليها العرف،ثمّ
مبادئ القانون الطّبيعي،و العدالة.
و موضوعنا هذا برّمته يتبلور في إشكالية أساسية مفادها:
- ماهي المصادر الاحتياطية للقانون،و ما مدى أهميتّها ؟
* المبحث الأوّل: الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي للقانون.
تعدّ
الشريعة الإسلامية المصدر الاحتياطي الأوّل حسب ما جاء في ترتيب المادّة
الأولى من القانون المدني الجزائري،فهي تعتبر مصدرا مادّيا،و رسميا في نفس
الوقت،أضف إلى ذلك هي نظام شامل لجميع مجالات الحياة - الرّوحية، و
الأخلاقية، و العملية – دون أن نفصّل بين أجزائها، و جوانبها المختلفة.
- المطلب الأوّل: مفهوم الشريعة الإسلامية لغة، و اصطلاحا
تستعمل
كلمة الشريعة في لغة العرب في معنيين:أحدهما الطّريقة المستقيمة؛ و من هذا
المعنى قوله تعالى: ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبّعها، و لا تتبّع
أهواء الذين لا يعلمون الجاثية (08).
و الثاني هو مورد الماء الجاري
الذي يُقصد للشُرب، و منه قول العرب:'' شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء
لتشرب ''، شبهتها هنا بمورد الماء لأنّ بها حياة النّفوس، و العقول، كما
أنّ في مورد الماء حياة للأجسام.
و أمّا في الاصطلاح الفقهي: فتطلق على
الأحكام التّي شرّعها اللّه لعباده على لسان رسول مــن الرّسل، فسميّت هذه
الأحكام بالشريعة لأنّها مستقيمة لا انحراف فيها عن الطّريق المستقيم؛
محـــكمة الوضع لا ينحرف نظامها، و لا يلتوي عن مقاصدها.أمّا
الإسلامية:فهذه نسبة إلى الدّين الإسلامي الذي يستعمل في الاصطلاح
الشّرعي؛ بمعنى الانقياد لأوامر الله، و التّسليم بقضائه، و أحكامه، و إلى
العقائد الأهلية، و الأسس، و المبادئ للعقيدة الإسلامية، فالدّين، و
الشّريعة، و الملّة بمعنى واحد.
- و من الشّريعة الإسلاميّة بمعناها
الفقهي؛ اشتّق الشّرع، و التّشريع؛ بمعنى سنّ القواعد القانونية سواء عن
طريق الأديان،و يسمّى تشريعا سمويًا،أم كانت من وضع البشر،و صنعهم؛فتسمّى
تشــريعا وضعيًّا.
.المطلب الثانـي: التفرقة بين الفقه الإسلامي،و مبادئ الشريعة الإسلامية .
فـالفقه
هو الاجتهاد للتّوصّل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدّلة
التّفصـيلية،و هو الجانب العملي من الشّريعة،و قد نشأ تدريجيا منذ عصر
الصّحابة نظرا إلى حاجة النّاس لمعرفة أحكام الوقائع الجديدة (1)، وظهرت
عدّة مذاهب فقهية إلى أن انتهى الأمر إلى اســتقرار الأربعة مذاهب
الرئيسية؛و هي:المذهب المالكي، و الحنفي، و الشافعي، و المذهب الحنبلي.و
تتميّز هـذه المذاهب باختلافها في بعض الأحكام التّفصيلية.
أمّا
بالنسبة لـمبادئ الشّريعة؛فهي الأصول الكليّة التّي تتفرّع عنها الأحكام
التّفصيلية،فهي المبادئ العامّة التّي لا تختلف في جوهرها من مذهب لآخر،و
هذا يعني أنّ النّظام القانوني في الشّريعة الإسلامية قائم على قواعد، و
أحكام أساسيّة في كلّ الميادين، و أنّ نصوص الشّريعة الإسلامية أتـــت في
القرآن،و السنّة بمبادئ أساسية،و تركت التفصيلات للاجتهاد في التّطبيق
بحسب المصالح الزمنية، إلاّ القليل من الأحكام التّي تناولتها بالتفصيل
كأحكام الميراث، و بعض العقوبات،و من ضمن المبادئ الأساسية في قسم الحقوق
الخاصّة:
أ. اعتبرت الشّريعة الإسلامية كلّ فعل ضارّ بالغير موجبا
مسؤولية الفاعل،أو المتسّبب، و إلزامه بالتعويض عن الضرر، و هذا المبدأ
تضمنّه الحديث الشّريف:" لا ضرر، و لا ضرار ".
ب. مبدأ حسن النيّة في المعاملات،تضمنّه الحديث الشّريف:" إنّما الأعمال بالنيّات ".
ج. مبدأ أنّ العقد ملزم لعاقديه،فقد تضمنّته الآية القرآنية: يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة
د.
المتعاقدون أحرار في وضع شروطهم إلاّ ما يخالف النّظام العام،و الآداب
العامّة،و هذا ما تضمنّه الحديث الشّريف: " المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطا
أحلّ حراما، أو حرّم حلالا ".
_____________________________
(1) د. وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي،و أدّلته،دار الفكر 1985 ،الجزء الأوّل،ص15 إلى 26 .
- المطلب الثالث: مصادر الأحكام الشرعية المتّفق عليها.
لقد
اتّفق جمهور المسلمين على الاستناد على أربعة مصادر؛وهي
القرآن،السنّة،الإجماع، و القياس، و الدّليل على ذلك حديث معاذ بن جبل(رضي
الله عنه)"الذي بعثه رسول الله(صلّى الله عليه،و سلم) قاضيا بالإسلام إلى
اليمن، -فقال له الرّسول:كيف تقضي يا معاذ إذا عُرِضَ لك قضاء ؟-قال: أقضي
بكتاب الله.-قال:فإن لم تجد في كتاب الله ؟-قال:فبسنّة رسول الله.-قال:فإن
لم تجد في سنّة رسول الله.-قال:أجتهد برأيي،ولا آلو.أي لا اُقصّر في
الاجتهاد.فضرب رسول الله(صلّى الله عليه،وسلّم) على صدره، و قال:الحمد لله
الذي وفّق رسول الله لما يرضى الله، و رسوله".
و نتناول هذه المصادر بالتّرتيب، و بالتّفصيل الآتي:
أوّلا: القرآن الكريم
هو
كتاب الله، نزل القرآن على النبيّ صلّى الله عليه،و سلّم، منّجمًا على مدى
ثلاث، و عشرين سنة؛ فبعض الآيات صرّحت بالأحكام مباشرة، و حدّدتها تحديدا
قاطعا، كآيات العبادات،و المواريث،و آيات تحريم الزنا،و القذف،و القتل
بغير حقّ،و بعض الآيات لم يُعَيَّن المراد منـها على وجه التّحديد؛ فكانت
محلّ الاجتهاد إذ لم يفصّل فيها، و جاءت بصيغة الإرشاد، والتّوجيه،
كالآيات المتعلّقة بالمعاملات الماليّة،و حتّى التّي فصّل فيها اكتفت
بالإرشاد، و التّوجيه، كآيات المداينة مثلا.
و قيل في تبرير هذا أنّ
هذه الآيات خاصّة بمعاملات تتغيّر بتغيّر الظروف،و تطوّر الزّمن، لذلك
اكتفى القرآن فيها بالقواعد الكليّة حتّى يكون النّاس في سعة من أمرهم.
و
الذي يتصدّى لاستنباط الأحكام الشّرعية من القرآن الكريم لابدّ أن يعرفه
كلّه،و هو أكثر من ستّة آلاف آية منها ما نسخ،و منها ما عدّلت أحكامها،و
لم يختلف الفقهاء في نسخ القرآن،و لكنّهم اختلفوا في نسخ القرآن
بالسنّة.فقد أجاز فقهاء المذهب الحنفي ذلك،و رأوا أنّ آية المواريث التّي
جاء
فيها : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة
للوالدين، و الأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين ، قد نسخت بحديث رسول
الله (صلّى الله
عليه،وسلّم): "لاوصيّة لوارث "، لكن جمهور
الفقهاء لا يتقّبلون نسخ الكتاب بالسنّة،و لو كانت متواترة (1) لـقوله
تعالى: ما ننسخ من آية،أو نسنّها نأت بخير منها، أو مثلها ألم تعلم أنّ
الله على كلّ شيء قدير.
ثانيا: السنّة
السنّة هي ما صدر عن قول
عن رسول الله(صلّى الله عليه، و سلّم) فتسمّى سنّة قولية،و قد تكون
فعلية؛و هي ما تستخلص من أفعال الرّسول (صلّى الله عليه،و سلّم)،و لا بدّ
من تحليل القول، و الفعل،و دراسة المصدر هل هو مقبول، أو لا. و قد تكون
السنّة تقريرية، و هي أن يسكت الرّسول عن عمل،أو قول، و هو حاضر، أو غائب
بعد علمه به.و قد يبدي الرّسول موافقته، أو يظهر استحسانه له (2)، و هناك
من يزيد عن سبعة آلاف حديث تتطّلب من المجتهد قدرا من النّباهة، و قد
اختلفت المذاهـب في الأخذ بالأحاديث وفقا للثقة في الرّاوي،و الصّفات
التّي يجب أن تتوافر فيه.
ثالثا: الإجماع
إنّ الحاجة المّاسة إلى
الحكم في القضايا الجديدة في عصر الصّحابة بعد وفاة النّبي(صلّى الله
عليه،و سلّم) أدّت إلى نشأة فكرة الإجماع عن طريق الاجتهاد الجماعي.ّ
و
الإجماع عند جمهور الفقهاء؛هو اتفّاق المجتهدين من اُمّة محمد(صلّى الله
عليه،و سلّم)بعد وفاته في عصر مـن العـصور على حكم شرعي (3)، و هنـاك من
يرى ضرورة اتـفّاق جميع المجتهدين لـقول الرّسول(صلّى الله عليه، و سلّم):
" لا تجتمع أمّتي على ضلالة "، و يذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يكفي إجماع
أكثر المجتهدين، و يستدّلون بقول الرّسول(صلّى الله عليه و سلّم):" أصحابي
كالنّجوم بأيّهم اقتديتم،اهتديتم ".و الإجماع عند جمهور الفقهاء هو اتفّاق
جميع المجتهدين.
___________________________________
(1) د. وهبة الزحيلي :أصول الفقه الإسلامي،المرجع السّابق،الجزء الثاني،ص971 و 972.
(2) د. وهبة الزحيلي :أصول الفقه الإسلامي،المرجع السّابق،الجزء الأوّل،ص 450.
(3) د. وهبة الزحيلي : نفس المرجع،ص 490 .
و
يرى الأستاذ أبو زهرة أنّه بعد إجماع الصّحابة الذي كان متواترا، و الذي
لم يختلف على إجماعهم أحد، تنازع الفقهاء في الإجماع، و لا يكادون يجمعون
على إجماع (1).
و لكن يرّد على هذا الرأي بأنّه لا يمكن قصر الإجماع
على الصّحابة فهو في متناول أهل كلّ عصر (2) لقول رسول(صلّى الله عليه، و
سلّم): " لا تزال طائفة من أمتّي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم خلاف من
خالفهم حتّى يأتي أمر الله ".
رابعا: القياس
و هو إلحاق أمر غير
منصوص على حكمه الشّرعي بأمر منصوص على حكمه بالنصّ عليه في الكتاب و
السنّة لاشتراكهما في علّة الحكم.و هو مشتّق من أمر فطري تقرّه العقول، و
يفرضه المنطق،إذ أساسـه ربط بين الأشياء المتماثلة إذا وُجـِدَت صفات
موّحدة بينها، فلابدّ من اشتراكهما في الحكم. و القياس هو أعمال للنّصوص
الشّرعية بأوسع مدى للاستعمال، فهو ليس تزيّدا فيها، و لكن تفسير لها(3).
و
أركان القياس هي:الأصل؛ و هو المصدر من النّصوص الذي يبيّن الحكم، الفرع؛
و هو الموضوع الذي لم ينّص على حكمه، أمّا الحكم؛ فهو الأمر الذي اتّجه
القياس إلى تَعَدِّيه من الأصل إلى الفرع لوجود علّة مشتركة بينهما.فإذا
قال سبحانه،و تعالى مثلا : إنّما الخمر،و الميسر، و الأنصاب، و الأزلام
رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون .
فهذا نصّ عن الخمر،و
الحكم هو تحريمه،و العلّة من تحريمه هي الإسكار،و كذلك هو الضرر الغالب إذ
يقول سبحانه،و تعالى : يسئلونك عن الخمر،و الميسر قل فيهما إثم كبير،و
منافع للنّاس. فيمكن بهذا إلحاق النّبيذ بالخمر، و يعتبر النّبيذ فرعا، و
يمكن الإلحاق به كلّ ما فيه ضرر غالب فيكون حراما. و القيّاس الصّحيح هو
الذي لا يتعارض مع الكتاب، و السنّة بل يعدّ تطبيقا لهما.
___________________________________
(1) الإمام محمد أبو زهرة:أصول الفقه، دار الفكر، القاهرة، بدون تاريخ ص 198.
(2) د. وهبة الزحيلي :أصول الفقه الإسلامي،المرجع السّابق،الجزء الأوّل،ص 533.
(3) الإمام محمد أبو زهرة:المرجع السّابق، ص 204 إلى 209.
- المطلب الرابع:
مكانة مبادئ الشريعة الإسلامية من بين مصادر القانون الجزائري.
إنّ الشّريعة الإسلامية تعدّ مصدرا رسميّا للقانون الجزائري إذ تنّص المادة الأولى من القانون المــــدني
على ذلك، فعلى القاضي إذا لم يجد حكما في التّشريع الرّجوع إلى مبادئ الشّريعة الإسلامية، و يقوم
باستخلاصها من الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و القيّاس، و ذلك باعتبار الشّريعة الإسلامية المصدر
الرّسمي الثاني بعد التّشريع.
و تعدّ الشريعة الإسلامية أيضا مصدرا مادّيا للقانون الجزائري، و المقصود بذلك أنّ المصدر المـــادّي،
أو
جوهر بعض نصوص القانون استمدّها المشرّع من مبادئ الشريعة الإسلامية،
فيعدّ قانون الأسرة مستمّدا من الشريعة الإسلامية فيما يتعلّق بالزّواج، و
الطّلاق، و الولاية، و الميراث، و الوصيّة، و الوقف،وتعدّ الشريعة
الإسلامية أيضا مصدرا مادّيا لبعض نصوص القانون المدني منها حوالة
الدّين،و كذلك استّمد القانون المدني الأحكام الخاصّة بتصرّفات المريض مرض
الموت من الشريعة الإسلامية كما تعـدّ أحكام خيار الرؤية المعروفة في
الشريعة الإسلاميّة مصدرا مادّيا للمادّة 352 مدني.و نظرية الظروف
الطّارئة التّي نصّ عليها القانون الوضعي مأخوذة من نظرية العذر في
الشريـعة الإسلامية، و إن كان يتـرّتب عليها فسخ العقد بالنّسبة لمبادئ
الشريعة الإسلاميّة بينما يترّتب عليها تعديل الالتزامات مع بقاءالعقد
قائما بالنّسبة للقانون الوضعي.
و قد جعل المشرّع الجزائري القرض بفائدة بين الأشخاص باطلا وفقا للمادّة 454 من القانون المدني،
و المصدر المادّي لهذا النّص هو الشريعة الإسلامية.
و يلاحظ أنّه إذا كانت الشريعة الإسلامية مصدرا مادّيا لبعض النّصوص التّشريعية، فذلك يعني أنّ
القاضي ملزم بالنّـص التّشريعي،و لا يرجع إلى مــبادئ الشريعة الإسلامية إلاّ لمــساعدته على تفسير
النّصوص المستمدّة منها.
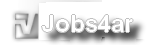




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

