بحث جاهز حول محور المدرسة بحث عن المدرسة للسنة السابعة 7 اساسي
بحوث السنة السابعة اساسي
تقديم:
إذا كان الباحثون يرجعون ظهور المدرسة إلى تقسيم المجتمع للعمل: عمل فكري و عمل يدوي، فإن ظهور "المدرسة العمومية" l’école publique هو الذي جعل الكل يوليها الاهتمام الكبير لأنها أصبحت تمس جميع شرائح المجتمع. و لذا، تزخر أدبيات التربية بتراث و دراسات حول المدرسة و وظائفها المختلفة. غير أنه يلاحظ بقدر ما نالته و حظيت به المدرسة من مدح و ثناء و تمجيد في التراث التربوي، بقدر ما تعرضت له من تقريع و نقد في الدراسات الحديثة.
لقد اعتبرت المدرسة العمومية في أول نشأتها قاطرة التقدم و فاتحة عهد جديد للمساواة أمام التعليم، و رمزا لحرية الإنسان و انعتاقه من الجهل (من فتح مدرسة فقد أغلق سجنا)، و وسيلة لتهذيب سلوك الفرد و تطوير قدراته و شحذها. و هكذا فتحت أبوابها لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس بحماس و ثقة، واعدة إياهم بالغد المشرق.
واستمرت وثيرة التمدرس، و بتزايد عدد المتمدرسين بدأت المشاكل تظهر بسرعة، خصوصا على مستوى الفشل الدراسي الذي بدأ يحصد ضحاياه بصورة أكبر ضمن أبناء الفئات المحرومة اجتماعيا، و بدأت الانتقادات توجه إلى المدرسة إما لصرامة القوانين المنظمة لفضائها و التي تخنق التلميذ (المدرسة الثكنة école-caserne) و إما لطريقة تعاملها مع ثقافة المجتمع و كيفية تقويمها للتلاميذ و اصطفائهم (مدرسة النخبة école élitique) و إما لعلاقتها بالمجتمع و حاجياته و مدى انفتاحها على سوق العمل.
كل هذا، جعل ذلك الحماس السابق يفتر ليحل محله التأمل، مما فتح الباب على مصراعيه لإعادة مساءلة المدرسة عن هويتها و وظائفها داخل المجتمع.
أولا- مفهوم المدرسة:
كثيرا ما نسمع أو نقرأ هذه العبارات:
ذهب ابني إلى المدرسة – ذهب ابني إلى الجامعة – أزمة المدرسة – المدرسة المغربية – المدرسو مجتمع صغير … الخ.
إذا كانت لفظة "مدرسة" تعني غالبا لدى الإنسان العادي المدرسة الابتدائية دون غيرها، فإن هذا المصطلح له في أدبيات التربية استعمالات عدة يمكن إجمالها في ثلاثة حسب إزامبير جماتي-2- Isambert Jamati:
1- المدرسة كمفهوم مجرد:
و هو المفهوم الذي نجده غالبا في التعاريف كقولنا "المدرسة مجتمع صغير" أو "المدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية". فنحن نتحدث عن المدرسة بصورة عامة، و لا نعني بها أية مدرسة و لا أي مجتمع، مهتمين فقط بالقاسم المشترك بين المدارس، رغم إيماننا بالاختلافات الكثيرة بينها. و هذا هو شأن التعاريف العامة.
2- المدرسة كمفهوم مرادف للنظام التربوي بالنسبة لوحدة سياسية معينة:
و في هذا الإطار، غالبا ما يتم الحديث عن أنماط التعليم و توجهاته و غاياته و تراتبيته و علاقته بالنظام الاجتماعي و السياسي، كما يدل على ذلك مثلا كتاب "المدرسة الرأسمالية في فرنسا" لبودلو و إستابلي.
و هنا تجدر الإشارة كذلك إلى أن مفهوم المدرسة قد يتموقع بين المجرد و المشخص، كقولنا: "المدرسة المغربية خلال فترة الاستقلال". فحصرها زمنيا و مكانيا، يجعل منها واقعا مشخصا، غير أنها و مع ذلك، تظل مفهوما مجردا لأننا نتعامل معها كواقع يشكل وحدة، في حين أن الأمر غير ذلك. فكما يوضح ذلك "بودلو و إستابلي"، إن هذا يحجب عنا الفروق الداخلية للأنظمة. "فمدرسة القرية" و المدرسة العليا للأساتذة كلاهما مدرسة: اسم واحد لشيئين مختلفين. و لذا يعتقد "بودلو و إستابلي" أن الحديث عن المدرسة كوحدة متجانسة لفظة مضللة و خادعة.
3- المدرسة كمفهوم مشخص-واقعي أي كمؤسسة:
تدل هنا المدرسة على مؤسسة معينة institution كالجامعة أو الثانوية أو المدرسة الابتدائية أو مؤسسة الروض -3- (خاصة حينما تكون هذه الأخيرة مندرجة في بنية التعليم).
و غالبا ما نجد الدراسات الاجتماعية التي تنحو هذا المنحى تكون مونوغرافية monographiques، أي تتسم بدراسة وافية لموضوع واحد انطلاقا من حالة أو عدة حالات، أو أن تأخذ المؤسسة كوحدة و تختبر الفرضيات التي حددتها انطلاقا من العلاقة بين هذه المتغيرات أو تلك داخل نفس المؤسسة، و بالتالي الوقوف على الخصوصيات التي تميزها.
ثانيا- دراسة المدرسة:
إن المدرسة حبلى بالمتغيرات و العوامل التي تغري بالدراسة، منها ما تم توليده و بالتالي توضيحه، و منها ما هو في طور المخاض. و لذا فهدفنا ليس هو عرض الدراسات الاجتماعية التي تناولت المدرسة، فهي كثيرة و متنوعة و تحتاج إلى مؤلف خاص بها، و لكن نحاول فقط الإشارة إلى التوجهات العامة التي اندرجت في إطارها اهتمامات هذه الدراسات.
تميل إزامبير جماتي -4- إلى عرض اهتمامات الدراسات التي تناولت المدرسة وفق محورين: محور المدرسة كمجتمع، و محور المدرسة داخل المجتمع.
1- المدرسة كمجتمع:
إنها تتناول المدرسة كمجتمع مصغر، و هو تقيليد "دوركايمي" (نسبة إلى Durkheim) يعتبر المدرسة لها وحدتها و وجهها الخاص بها و نظامها تماما مثل مجتمع الراشدين و من ثمة فهي تشبه المجتمع الكبير و تستمد منه نظامها.
غير أن الدراسات الحديثة التي تناولت المدرسة كمجتمع ركزت خاصة على دراسة المؤسسة institution من حيث:
- مرفولوجية المدرسة: هيكلها المادي و بناياتها و حجراتها و شكلها و تجهيزاتها … الخ و غالبا ما يتم مماثلتها بالمعمل أو المصنع.
- نمط القيادة و علاقته بحجم المؤسسة و نمط التسيير المالي للمؤسسة … الخ فقد أثبتت الملاحظات مثلا أن المؤسسة حينما تتجاوز عددا معينا من التلاميذ، فإن العلاقات البيروقراطية تبدأ في الظهور. كما أن مصادر التمويل و أشكال التسيير لها أثر على علاقات السلطة داخل المؤسسة (تلاميذ، مدرسون، إدارة) و تختلف علاقات السلطة داخل المؤسسة من حيث تمويلها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو مشاركة الآباء في التمويل و التسيير عبر جمعية الآباء … الخ
- بنية المدرسة: البحث عن الخصائص البنيوية للمؤسسة التي لها علاقة بالتربية كدراسة إزامبير-جماتي و آخرين حول أثر البنية التربوية على سير المؤسسة و مناخها …
2- المدرسة داخل المجتمع:
إذا كان المحور الأول يميل إلى تناول المدرسة كمؤسسة لها نظامها الخاص بها، و بالتالي دراسة أثر متغيرات المدرسة على الحياة داخل المدرسة نفسها، فإن المحور الثاني ينحو عبر دراساته إلى تناول المدرسة في علاقتها ببنيات المجتمع و معرفة مدى التفاعل الحاصل بينها و بين مؤسساته و فئاته الاجتماعية … الخ، و من ثمة يطرح هذا المحور مجموعة من القضايا على بساط البحث منها:
- علاقة المدرسة بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى كالأسرة مثلا.
- علاقة المدرسة بالطبقات أو الفئات الاجتماعية من حيث: ولوج المدرسة، المسار الدراسي، التخرج النهائي، الثقافة، النجاح أو الفشل الدراسي … الخ.
- علاقة المدرسة بثقافة المجتمع و بالتغيير الاجتماعي: وظائف المدرسة الخ…
و لنأخذ من محور "المدرسة داخل المجتمع" قضية مهمة و هي "وظائف المدرسة" لنتعرف أكثر على علاقة المدرسة بالمجتمع.
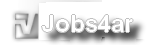


 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
